وقفات أوليفيه روا مع “الجهل المقدس” (1/2)
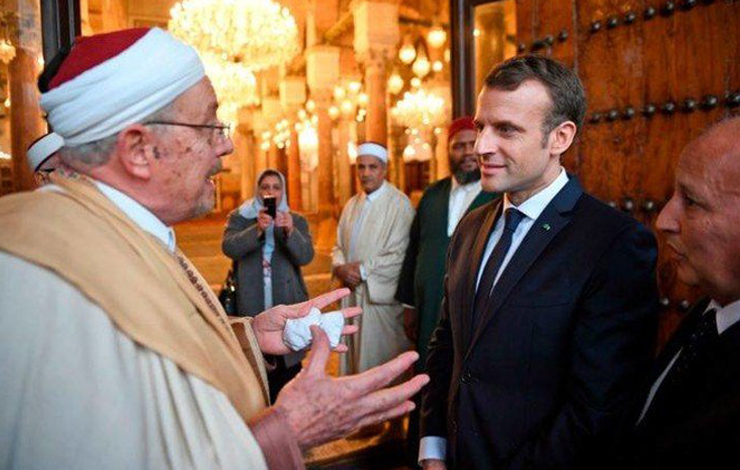
بقلم: منتصر حمادة
بصدور كتاب “الجهل المقدس.. زمن دين بلا ثقافة”، يؤكد الباحث الفرنسي أوليفيه روا، أنه باحث من طراز كبير ونوعي هناك في المجال التداولي الغربي (الفرنسي نموذجا)، ومع أن الرجل اشتهر عند المتلقي العربي من خلال لائحة من الأعمال الجادة والمرجعية في تناول الظاهرة الإسلامية الحركية، ونخص بالذكر ثلاثية “فشل الإسلام السياسي”، “أوهام 11 سبتمبر”، “عولمة الإسلام” أو “الإسلام المُعولم” كما جاء في ترجمة مغايرة.. إلا أن عمله الجديد هذا، يرتقي به مرتبة في سلم البحث العلمي الرصين. نحن في ضيافة كتاب “الجهل المقدس.. زمن دين بلا ثقافة” لأوليفيه روا، وترجمه صالح الأشمر، صدر عن دار الساقي، وجاء في 341 صفحة.

يتطرق المؤلف لجميع الديانات التوحيدية (اليهودية والمسيحية والإسلام)، ومعها العقائد الوضعية، لم يترك أي قارة دينية “مطمئنة البال”، خاصة أنه يعالج ثنائية العولمة والأصولية ـ نقصد الأصولية في الديانات الثلاث طبعا، ولدى باقي الطوائف والمعتقدات.. ـ كما أنه يتطرق لموضوع التحولات الدينية من هذا الدين إلى دين آخر، وهذا موضوع تطرق إليه الباحث المصري هاني نسيره في أحد أعماله، ويحمل عنوان: “الحنين إلى السماء”، حيث يرصد تحولات بعض الأقلام المحسوبة على المرجعية العلمانية، هناك في مصر المحروسة نحو التوجه الديني. قراءة الكتاب، تعفي المتلقي من مطالعة العديد من الدراسات والأعمال المُخَصّصة لملف الحركات الإسلامية (دعوية، سياسية أو “جهادية”)، وهذه لوحدها، “حسنة” لا تقدر بثمن، إن لم تكن من أهم “حسنات” الكتاب، ما دامت تساعد القارئ غير المتتبع أو غير المتخصص في معرفة أسباب اختلاف طباع التديّن بين أهل الكويت وأهل كابول، عند أهل التديّن الإسلامي، وهكذا دواليك مع طبائع التديّن عن اليهود والمسيحيين..
مما يُميز الكتاب أيضاً، أنه يُمرر مفاتيح مفاهيمية تساعد المتلقي غير المتتبع على قراءة أسباب عداء التيارات الأصولية للظاهرة الفنية، كما نعاين ذلك في المجال الإسلامي مثلاً، لأن الحفر العلمي للمؤلف في ثنائية الدين والثقافة، سيفضي إلى تسليط الأضواء على العديد من النقاط والظواهر المسكوت عنها أو المغيبة من التداول البحثي أو الإعلامي. يجب التذكير في سياق التوقف العابر عند مضامين هذا العمل، أن أوليفيه روا، مرّ في طفولته من تربية مسيحية ملتزمة، قبل الانعطاف على تحولات فكرية لاحقاً جعلت منه اليوم، قلماً فرنسياً مرجعياً في تناول القضايا الدينية، وبالتالي في تعامله مع ثنائية الدين والتديّن، حيث إنه يؤسس تناوله هذا على الحذر المعرفي والابتعاد عن تمرير أحكام القيمة، بخلاف السائد مع أغلب المستشرقين القدامى والجدد، في أوروبا وأمريكا، مع بعض الاستثناءات الهامة التي نلمسها لدى تيار عريض من المستشرقين الألمان على الخصوص. (هناك عمل صغير الحجم، وكبير الفائدة بالنسبة للذين يبحثون عن تقييم الاستشراق الألماني، وألفه رضوان السيد).

جاء كتاب أوليفيه روا موزعاً على توطئة، ومدخل تحت عنوان “الحداثة والعلمنة وعودة الديني”، وسبعة فصول موزعة بدورها على قسمين: “اندراج الديني في الثقافة” (تضمن الفصول التالية: عندما يلتقي الديني الثقافة؛ من الحضارة إلى التعددية الثقافية، دين، عِرق، أمة؛ الثقافة والدين: القطيعة)، و”العولمة والديني”، (السوق الحرة أم الهيمنة بواسطة السوق؟ سوق الديني، وأخيرا، توحيد نمط الديني).
هذه نماذج من الأسئلة المؤرقة والمؤطرة لهذا العمل القيم، كما نطلع عليها في مدخل الكتاب: لماذا يصبح عشرات الآلاف من المسلمين في آسيا الوسطى مسيحيين أو شهود يهوه؟ وكيف أمكن لكنيسة بروتستانتية إنجيلية أن تتجذر في المغرب أو الجزائر؟ ولِمَ تحقق الإنجيلية البروتستانتية اختراقاً مدهشاً في البرازيل ـ بلغ عدد أتباعها 25 مليونا في عام 2007 ـ أو في إفريقيا الغربية؟ وكيف نُفسر كون الخمسينية أو العَنْصَرِيَّة هي الدين الأسرع نمواً في العالم؟ ولم تستهوي السلفية الجذرية شبانا أوروبيين، بيضاً أو سوداً؟ وكيف أضحت القاعدة التنظيم “الإسلامي” الذي يضم أكبر نسبة مئوية من المتحولين إلى الإسلام؟ وعكسيا، لماذا تجد الكنيسة الكاثوليكية كثيراً من العناء في الاحتفاظ برعاياها وتشهد هبوطاً في عدد المُلبين لدعوة الرب في الغرب؟ ولِمَ باتَ المدافعون عن التقليد الأنغليكاني المحافظ هم اليوم نيجيريون وأوغنديون أو كينيون، في حين يؤيد كبير أساقفة الكنيسة الإنكليزية، رويان ويليامز، اعتماد الشريعة الإسلامية في القانون المدني للمسلمين البريطانيين ويجيز رسامة الكهنة المثليين؟ ولماذا تنكفئ الكنائس الأرثوذكسية على الهويات القومية، بخلاف البروتستانتية، وعلى غرار الهندوسية؟

لم تسلم العديد من الأطروحات الفكرية المروج لها خلال العقدين الأخيرين من المطرقة النقدية للمؤلف، لعل أبرزها أطروحة “صدام الحضارات” بتعبير صامويل هنتنغتون (أو “الحرب الحضارية” بتعبير المهدي المنجرة)، حيث اعتبر أوليفيه روا أن نظرية صدام أو حوار الحضارات لا تتيح فهم هذه الحركات المزعزعة التي تخلط الخرائط والأقاليم والهويات، وتحطم الروابط التقليدية القائمة بين الدين والثقافة، مُطالبا مروجي هذه الأطروحات بالحفر النقدي في مآلات انفصال الدين عن الثقافة، أو انفصال الدين عن جذوره الثقافية؟ أو على نحو أبسط، كما يتساءل روا: لِمَ تبدو الأديان اليوم وكأنها هي التي تضطلع بإعادة ترتيب للهويات؟
في إطار البحث عن أجوبة مُقنِعة للأسئلة المُركبة التي افتتحَ بها المؤلف عمله هذا، توقف عند مقتضيات أهم فرضيات الساحة: تُفيد الأولى أن العلمنة سيرورة حتمية، وكونها شرطاً للحداثة ونتيجة لها في آن؛ في حين تُفيد الثانية أن عودة الديني، تُجسّد صرخة ضد حداثة مستلبة أو وهمية، أو نوعاً ما أشبه بصيغة مختلفة للدخول في الحداثة، ويضيف روا أن الأمر لا يتعلق بجدل فكري صرف، لأنه في فرنسا، نجده في صلب النزاع حول اللائكية، من خلال عدم الحسم مع ازدواجية نظرية وعملية: هل ينبغي فرض اللائكية في مقابل الدين، وعلى حساب الحرية الفردية إذا اقتضى الأمر؟ أم إن التجديد الديني ما هو إلا انعكاس للتنوع، والغنى وللحرية الإنسانية؟ لولا أن هذا الجدل ينطوي على سوء فهم كبير: فالعلمنة لم تنسف الديني، وهي إذ تَفصِل الديني عن بيئتنا الثقافية فإنها تُظهره على العكس كديني محض. وقد عملت العلمنة عملها في الواقع: فما نشهده إنما هو إعادة صياغة مناضلة للديني في فضاء مُعَلَمن أعطى الديني استقلاله الذاتي وتاليا شروط توسعه: لقد أرغمت العلمنة والعولمة الأديان على الانفصال عن الثقافة، وعلى أن نعتبر نفسها مستقلة وتعيد بناء ذاتها في فضاء لم يعد إقليميا وبالنتيجة لم يعد خاضعا للسياسي. وينجم فشل الديني إسلاميو، حكومة دينية من أنه أراد منافسة العلمنة في ميدانها الخاص: الفضاء السياسي (أمة، دولة، مواطن دستور، نظام قانوني).
بهذا المعنى والاجتهاد الذي سَطره المؤلف، لا تعدو “عودة” الديني أن تكون من قبيل الوهم البصري: يجدر الحديث عن تحول الدين أمكن للرؤية وغالبا ما يكون منحرفا في آن، والأحرى أننا نشهد إعادة صياغة للديني لا عودة إلى ممارسة سلفية مهجورة إبان معترضة العلمنة، والملاحظ ـ كما نعاين ذلك بشكل جلي في الساحة العربية ـ أن هذه الاتجاهات تتماشى مع الرغبة في أوسع إمكانية رؤية الفضاء العام، وإحداث قطيعة بينة مع الممارسات والثقافات المهيمنة، ومن هنا تضطلع الأصولية بالقطيعة الثقافية، حيث يعتبر الأصولي ـ أو الإسلامي الحركي ـ أن معيار الانفصال هو الإيمان: لا نتقاسم إلا في الإيمان، أما التوافقي فيرى أن المؤمن يمكن أن يتقاسم ثقافة وقيما مشتركة مع غير المؤمن. بخصوص موضوع التحولات عن/ من دين إلى آخر، فإن مفردة تحول هنا يقصد بها حصرا تغيير الدين، فالمرء لا يتحول عن دين إلى ثقافة، ولعله يتكيف معها، أو يتعلمها، وتدل فجائية التحول دلالة واضحة على الانفصال بين ثقافة ودين، ولهذا السبب يعامل التحول غالباً معاملة المشتبه في أمره المتحول الخائن (عائد إلى الهرطقة مثلاً، مارق، مُتمرد، جاحد..) في نظر شركائه القدامى في الدين، وحديث عهد بالدين الجديد، تبقى حماسته مدعاة للريبة في نظر إخوانه الجدد.







