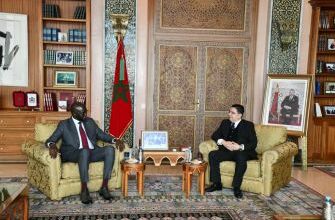في أنوارِ الإسلام وإسلامِ الأنوار..

محمد التهامي الحراق
خامرتني منذ مدة، ليست بالقريبة، فكرةُ أن أكتب مقالا بعنوان “الأنوار لا تتزاحم”؛ وذلك للإشارة إلى إمكان تقاطعٍ والتقاءٍ أكيدين بين “أنوار الإسلام” و “أنوار الحداثة”؛ وهو الإمكان الذي أفهمهُ اليوم من عنوان “إسلام الأنوار”. ظلت هذه الفكرةُ ضامرةً في خطاطاتي، إلى أن وجدت لمحةً قريبةً منها في مقدمة كتاب عبد النور بيدار “نحو إسلام يليق بزماننا” ؛ حيث ذهب إلى أن الجمع والوشج بين “أنوار الإسلام” و”أنوار الحداثة” قد يكون نوعا من التحقق بما ورد في الآية القرآنية من سورة النور: “نورٌ على نُور” ( سورة النور، الآية 35).
يحتاج، طبعا، مثلُ هذا الأفق إلى عمل “تنويري” كبير؛ قوامه عمل نقدي مزدوج بلغة الكبير عبد الكبير الخطيبي؛ نقد لكل ما يطمِس “أنوارَ الإسلام” في القراءات الانغلاقية والتعصبية والتحجرية، والتي اختزلت رحابةَ الدين في فهم تاريخي معين، وماهت بينه وبين روحِ الدين، مغلِقَة أفهامَ النص ومحَجِّرة على عقول المؤمنين وقلوبِهم، بحيث جعلت كلَّ نزوع للتحرر من هذا الحِجر، وكلُّ نزوعٍ لرفع “القصور” و”الوصايةِ”، أي كل نزوع للتنوير ، نزوعاً لمغادرة دائرة الدين وأرض الإيمان؛ بل إنها مارست الإقصاء والتهميش والإلغاء لفهومٍ رامت هذا الأفق التنويري في فهم الدين أكانت كلاميةً أم فلسفية أم صوفية أم نهضوية … وذلك بالزج بها خارج الإسلام أو على تخومهِ من خلال ترسانة من الأحكام المسبقة، وباستعمال معجم فقهي استبعادي يحتاج بدوره لمراجعة نقدية جذرية؛ مثل الفسق، الابتداع، المروق، الشرك، الكفر، الضلال، الزيغ، الزندقة…إلخ.
أول ما يقتضيه هذا العمل التنويري، إذن، هو الاضطلاع بجهد تفكيكي نقدي للتراث التفسيري الإسلامي، وذلك من أجل تحييد كل المفاهيم والمسبقات والمضمرات والمُسلَّمات التاريخية التي تنزع عن نفسها بعدها البشري والنسبي لتستعير صوتَ المطلق، وتحتكر النطقَ باسم السماء، و”تتألَّه” من حيث لا تدري، مما يجعلها تمارس “شِركا ابستمولوجيا”؛ لكونها تشرك في الألوهية رأيَها، وتنتحلُ الحديث باسم الحق المطلق، فيما هي محاولةُ فهم بشري محدود بحدود زمانهِ ومعرفته وأدواتهِ ووعيه ولا وعيه …، ومن ثم لا يمكنها قط أن تستنفد كلمات الله المطلقة، أو تمتلك بشكل كامل ونهائي ومطلق ومغلق معانيها؛ قال تعالى: ” قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً” ( سورة الكهف، الآية 109).
نحتاج إلى هذا العمل التفكيكي النقدي للتراث الفكري الإسلامي بامتلاك أدواته ومفاهيمه، ثم قراءتها قراءة نقدية تاريخية، لنحاول فرز الابستمولوجي الممتد منها من الابستمولوجي المتجاوَز؛ فضلا عن فصل المعرفي عن الإيديولوجي المتخلِّق من رحم نزاعات تاريخية وصراعات سياسية ومذهبية واجتماعية واقتصادية عبَّرت عن لهبها بمعجم ديني، بل أسهمت هذه النزاعات والصراعات في تشكيل هذا المعجم وصياغته، مثلما انتحلت النصوصَ المقدسة لتنسب إليها، وإليها فقط، ذاك المعجم، مما أدخل المسلمين في نزاعات وصراعات دموية باسم نفس الإله ونفس النص المقدس ونفس الرسول، وكذا باسم نفس المعجم والشعارات والثنائيات؛ لنتذكر تمثيلا ثنائيات الهداية/الضلال، الإيمان/الكفر، السنة/البدعة، الولاء/البراء، الحق/الباطل، الفرقة الناجية/الفرق الضالة … إلخ.
إن هذا العمل التفكيكي النقدي هو الذي من شأنه أن يخترق الطبقات التفسيرية، ويميطَ اللثام عن طراوة الدين وأنواره المطمورة والمنسية تحت أنقاض الأفهام التاريخية والبشرية التي حلّت محلّه، واختطفت عنوان القداسة ومشعلها منه، حتى بدا للبعضِ أن الدين لم يعد يملك طاقة تنويرية لأهل زماننا، ولا قدرة راهنية على إضاءة أسئلتنا واحتياجاتنا الوجودية هنا والآن. في حين أن إشراقات عدة تتخلل الموروث الفكري الإسلامي، في الفقه والكلام والتصوف والآداب والفنون، كانت قد انبجست في العصر “التنويري” الإسلامي سواء ببغداد أو البصرة أو الريّ أو مراكش أو فاس أو قرطبة….؛ أو في “التنوير الثاني” الذي انطلق في عصر النهضة العربية قبل أن يواجه أشكالا من الوأدِ… كل ذلك يؤكد على الإمكانات الهائلة التنويرية المنسية في القرءان الكريم والسيرة المحمدية، والتي جلَّت بعضَها فهوماتٌ عدة استثنائية للدين انطمست وتنوسيت بفعل عوامل تاريخية وسياسية وسلطوية وصراعية، لا لعدمِ صلاحيتها الدينية كما أوهمتنا بذلك التيارات القرائية المنتصِرة.
المسار الثاني الموازي لهذا العمل التفكيكي النقدي للتراث الفكري الإسلامي هو القيام بذات الاقتراب التفكيكي النقدي للأوجه الهيمنية والاستعمارية ثم الاستهلاكية المادية، ثم العلمانية الإلحادية، ثم العدمية الجارفة، لـ “الحداثة” وما بعدها، ومن ثم إظهار أشكال التحريف والتصحيف والزيغ والخيانة التي تعرضت لها الأبعاد التنويرية في الحداثة نفسها، فحوَّلت تمجيدَها للعقل والإنسان ووعُودَها بتحريرهما إلى ممارسات استغلالية إمبريالية، مما أفرز أنظمة ديكتاتورية وشمولية متوحِّشة، و دفع نحو انفجار نزوعات رأسمالية شرسة تؤلِّه الريح، وتشيِّء الإنسان، وتسلِّع كل شيء، ضدا على إنسانية الإنسان، وفي تجفيف قاس وفظيع لروحانيته باسم الحرية والمتعة والسعادة…؛ مع إفراغ كل هذا المعجم من دلالاته الإنسية، ومحْقِ أفقه الكوني الذي آمن بأنواره جمٌّ مِن البشرية.
طبعا، وُجد في الغرب، كما حصل في تاريخ المسلمين، من انتقد هذا الانحراف، ونبَّه على هذه الخيانة، مما فتحَ ويفتح إمكاناتٍ لتآزرِ “التنويريين” في “الجهتينِ”، من أجل صياغة مشروع إنسي يقوم على الحرية، وتقديس الانسان، ورفْعِ كل تناقض بين هاتين القيمتين الكونيتين وروحانية العالم التي تُعدُّ إزاحتُها موصولةً بنموذج غير إنسي للتدين، في حين يلوح في أفق التنويرِ إمكانُ استلهامِ نموذج تديني إنسي كوني روحاني، من شأنه أن يعيد الاعتبارَ لأنوارِ الدين وينقذ أنوارَ الحداثة؛ أي أن يعيد الاعتبار للقراءة التنويرية الإنسية في الأفقين بعيدا عن كل تصادم كان نتاجا لخيانةِ تلك القيم التنويرية في الدين مثلما في الحداثة.
الدين هنا لا يتقدم كوصيٍّ على العقل، بل كضامنٍ لحريته وانطلاقته، والروحانية تتقدم بوصفها هنا مرادفاً لـ”الحرية”، من حيثُ هي خروجٌ عن رقِّ الأغيارِ؛ ذلك أن “آخر مقام العارفِ الحريةُ” . إنها كذلك أيضاً في معناها الأنطولوجي، بحيث تحرِّر روح الانسان حيالَ كل ما يمكن أن يقمع ويكبت طاقتها اللانهائية في اكتشاف المتعالي الضامر في كينونة الإنسان، والذي بقدر تجلِّيه يقوِّي معنى حضور الانسان في العالم بوصفه “خليفة لله في الأرض” وفقَ التوصيف الذهبي القرآني.
الدين هنا، أيضا، ليس ذاك السجنُ الذي يطوّق عقلَ الإنسان وروحَه بما يحُول دون اكتشاف قدراته اللانهائية في التسيُّد في العالم لا على العالم؛ مثلما أن الحداثة هنا ليست ذاك العقلَ المتجبِّر الذي لا يُولد إلا بتمزيق الكتبِ المقدَّسة، لكونه يتوهم قدرتَه أن يتسيد على العالم ويسيطر على الطبيعةِ دون أيِّ احتياج إلى التعالي والقداسة. على العقلِ هنا أن يعيَ أن انغراسه كطاقة منطلقة من قلبِ الدين وفي تواؤم مع المتعالي بل وكحافر روحاني، أمر ممكن، مثلمَا عليه أن يدركَ أن الاغترار بتسيُّد العقل على حساب الروح والتعالي، أمرٌ مدمِّر للعقل وللإنسان كما برهَن التاريخ على ذلك، وجسَّده مسارُ خيانة التنوير الحداثي في الغرب. الأمر لا يتعلق، هنا، بمحاولةٍ ترميقية تلفيقية، بقدر ما يتعلق بمحاولةِ بناء علاقة نقدية بين الدين والحداثة تذهبُ في الاتجاهين بما يجعل التعالي منتِجا متواصلا للمعنى الذي تحتاجه الحداثة، ولا يلبّيه العقل المُفرَغ من التعالي، مثلما تجعلُ العقلَ متجدِّدا قادرا على الفهم والتفسير والفعل في التاريخ دون انحرافٍ عن المقاصد الإنسية والكونية التي رفعها العقل التنويري عندَ انبثاقِه.
نحن إزاء عملية إنقاذ متبادلة، خلالها ينقذ العقلُ القراءاتِ المنغلقة للدينِ من إعدام التعالي والقداسة، ويُنقِذ فيها التعالي العقلَ من التجبُّر والإفساد في الطبيعة و تدمير الإنسان. إنه أفق ثالثٌ لابد فيه من استلهامِ الصمت في القراءات الدينية والحداثية لقولٍ ثالث، يَخرج من ضيق الإعدام المتبادل بين الدين والحداثة إلى الاحتياج المتبادل لتصحيح الانحراف الذي مسَّ التعالي في الدين مثلما عصف برُشد العقلِ في الحداثة، إذ ذاك فقط يمكن أن نتحدث عن “أنوار لا تتزاحم” وقد أشرقْت من مَطلعَي الدين والحداثة.
إن هذا النقد المطلوب حيال تراثنا الإسلامي وحيال الحداثة، لا يعني بأي حال من الأحوال استجابةً ظرفية لأحداث سياسية ما تفتأ تصير وتتغيّر؛ ذلك أن ثمة قراءاتٍ تربط مثلا نقدَ التراث بتوجيهات غريبة للأحداث “تشويها للإسلام”، ومحاصرة له، وهو الفهم الذي يبقى أسير الظرفي والوقائعي المتحوِّل، و يتيح الارتكانَ إلى تفسير المؤامرة الذي يُعَد واحدا من أسلحة الذات الواعية واللاوعية لتحاشي النقد الذاتي الحتمي والضروري. نعم، نحن لا يمكن أن نبرِّئ أي جهة من العمل على توجيه الأحداث والانخراط في الصراع بما يلائم منظورَها ويحقّق مصالحها، ولكن هذا الأمرَ لا يشكل أبداً تعلّة لإعفاء الذات من المسؤولية في ممارسة النقد لتجاوز كل العوائق الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تجعلنا منفعلين لا فاعلين، وتبخّس من قدرتنا على إثبات فعاليتنا الحضارية العامة، والسياسية والاقتصادية والثقافية المخصوصة. فسؤال التراث والحداثة ظل متربصا بنا منذ ما يسمى بعصر “النهضة العربية” إلى اليوم، بحيث قاد سوءُ استيعابنا للصيرورة التاريخية وعجزُنا عن استيعاب الحداثة وتبيئتها في ثقافتنا من خلال إنجاز النقد المزدوج المطلوب؛ قاد ذلك إلى حصول رِدّة فكرية ونكوص حضاري، ويكفي لبيان ذلك مقارنة أولية للطروحات الانغلاقية للأصولانية الدينية اليوم بالأفق المنفتح الذي طرحه رواد “السلفية التنويرية” خلال عصر النهضة.
لنقل إن توالي الهزائم والأزمات على العالم الإسلامي عموما، والعربي منه تعيينا، وعجز حكومات ودول ما بعد الاستقلال عن صياغة نماذج تنموية فاعلة تحقق الوعود الهوياتية، فضلا عن الوعود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شكلت مضمون “إيديولوجية الكفاح” من أجل الاستقلال؛ هذا العجز أفضى إلى استئساد الاستبداد، وانهيار الآمال الطوباوية التي كانت معلَّقَة سواء على النموذج الاشتراكي أو القومي أو الليبرالي، مما أتاح المجال لأسطرة النموذج الذي حمله الإسلامُ السياسي، والذي وجد نفسه عاجزا عن استيعاب التاريخ وعن الانغراس في مستلزمات اللحظة الحديثة، بسبب معوقات ذاتية في وعيه، ولكونه لم يستطع ضبط الحدود المتحركة بين الديني والسياسي، فضلا عن افتقار مقولاته للاختبار التاريخي، والتي انكشفت عوراتُها بفقدان صلاحيتها الابستمولوجية والتاريخية منذ زمان، مثلما انكشفَ أنها مقولاتٌ وجدانية تحشيدية تجييشية أكثر منها مقولات معرفية فلسفية عميقة تلائم روح الدين وروح الحداثة.
من هنا حاجتنا إلى إسلام الأنوار؛ أي إلى إعادة الاعتبار لحوار الأنوار بين أنوار الإسلام وأنوار الحداثة، فثمة آفاق كاشفة لظلمات فهم الدين مثلما هي كاشفة لظلمات انحراف الحداثة….عملٌ لابد فيه من مسار نقدي مزدوجٍ في أفق إعادة ترتيب علاقة التعالي بالتاريخ، والروح بالعقل في سياقنا الإسلامي و الكوني في آن، وذلك طلبا لتبديد أنواع شتى من سوء الفهم والتفاهم بين النور المنبجِس من “الإيمانِ بالسؤال” وذاك المتلألئ من “سؤالِ الإيمان”.