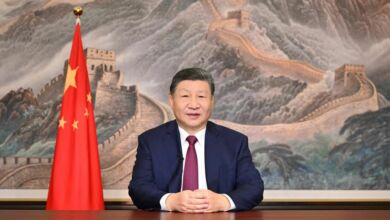الدار/
لم يكن مسار بناء دولة القانون بالمغرب وليد التعديل الدستوري لسنة 2011 في معزل عن ورش القوانين التنظيمية التي يفترض أن تمنح ذلك الدستور روحه العملية ونجاعته المؤسساتية. فالدساتير و مهما بلغت درجة تقدمها من حيث الصياغة والمبادئ، تظل نصوص معلقة ما لم تجد طريقها إلى التنزيل عبر قوانين تنظيمية تفعل مضامينها وتحول القيم المعلنة إلى حقوق قابلة لكل مطالبة أمام القضاء. و من هذا المنطلق لا يمكن النظر إلى القوانين التنظيمية بمنظار تقني ضيق، بل باعتبارها مؤشر دقيق على توازن السلط، وحدود المسؤولية التشريعية، ومستقبل الحماية القضائية للحقوق والحريات الدستورية.
في صدارة هذه القوانين التنظيمية، يبرز قانون الدفع بعدم دستورية القوانين بإعتباره الحلقة المفصلية التي تربط بين سمو الدستور والتشريع العادي. وهو القانون الذي طال إنتظاره لمدة خمسة عشر سنة، في مفارقة صادمة مع مقتضيات الدستور نفسه، ومع منطق الإنتقال الدستوري الذي جاء به دستور 2011، هذا التأخير لا يمكن وصفه بخلل عرضي أو بتباطؤ مسطري تشريعي، بل يشكل في جوهره تعليق غير معلن لأحد أهم مكتسبات الدستور المتمثل في تمكين المواطن، من خلال النوازل المعروضة على القضاء باعتباره طرف في الادعاء، من مراقبة مدى إحترام المشرع للدستور.
إن قاعدة سمو الدستور لا تكتسب معناها العملي إلا من خلال آلية فعالة تسمح بإخضاع القوانين للرقابة، ليس فقط قبل صدورها، بل كذلك بعد دخولها حيز التنفيذ، خاصة حينما يتبين من خلال التطبيق العملي أنها تمس بحقوق أو حريات دستورية.إن الدفع بعدم دستورية القوانين لا ينبغي إختزاله في كونه مجرد إجراء مسطري، بل هو إمتداد طبيعي للنظرية الدستورية الحديثة التي تجعل من الدستور قانون “حي” قابل للاحتجاج ومتصل مباشرة بحياة المتقاضين.
في هذا الباب تكتسي مذكرة نادي قضاة المغرب، المعروضة أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أهمية خاصة، لأنها أعادت فتح نقاش مؤجل حول جوهر العلاقة بين التشريع والدستور. فالاعتراض الذي أثارته المذكرة بخصوص المادة 27 من المشروع لا يمس مجرد تفصيل تقني بل يلامس سؤال تأسيسي مهم وهو مادمى كون المشرع معصوم من الخطأ؟ ليكون الجواب ووفق المنطق الدستوري المقارن، واضح لا لبس فيه، فالتشريع عمل إنساني يحتمل الصواب والخطأ، ولا يمكن تحصينه من المساءلة متى ثبتت مخالفته للدستور وتسببه في ضرر للغيرفي و في إطار مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية كذلك.
إن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره مبدأ دستوري ، يفقد معناه إذا أستثني الفعل التشريعي من نطاقه. والإقرار بمسؤولية الدولة عن الخطأ التشريعي لا يشكل انتقاص من مكانة البرلمان، بل على العكس يرفع من منسوب جودة التشريع، ويحث المؤسسة التشريعية على إستحضار الرقابة الدستورية باعتبارها جزء من الأمن القانوني للمواطن. وهذا ما نقف عليه من خلال تجارب قانونية وقضائية متقدمة تؤكد ذات التوجه، ففي فرنسا أقر القضاء الدستوري والإداري بمسؤولية الدولة عن القوانين غير الدستورية التي تحدث أضرار، وفي ألمانيا وإسبانيا يشكل الدفع بعدم الدستورية آلية مركزية لضمان إنسجام التشريع مع الدستور وحماية الحقوق الأساسية.
أما على المستوى السياسي والمؤسساتي، فإن قراءة مذكرة نادي قضاة المغرب تكشف عن تحول نوعي في تموقع السلطة القضائية داخل معادلة توازن السلط الدستوري. فنحن أمام خطاب قضائي لا يكتفي بدور “الفاعل التقني”، بل يضطلع بوظيفة دستورية أصيلة تتمثل في حماية الدستور من أي تحصين غير مشروع، حتى وإن تعلق الأمر بالمؤسسة التشريعية نفسها. ورفض إعفاء المشرع من المسؤولية هو في العمق رفض لمنطق الشرعية العددية غير المقيدة، وتأكيد على أن الإرادة الشعبية لا تستمد مشروعيتها إلا من خلال إحترامها للإطار الدستوري.
كما أن الدعوة إلى توسيع نطاق الدفع بعدم الدستورية ليشمل المحاكم المالية والعسكرية تعكس وعي متقدمي بوحدة الحماية الدستورية، ورفض لأي تجزئة للحقوق والحريات حسب طبيعة و إختصاص الجهة القضائية. وهو توجه ينسجم مع ما إستقر عليه القضاء الدستوري في أنظمة ديمقراطية عريقة، حيث لا يقبل أن تكون بعض المجالات أو الجهات خارج الرقابة الدستورية بدعوى الخصوصية.
ومن وجهة نظرنا المتواضعة، فإن نجاح آلية الدفع بعدم دستورية القوانين بالمغرب يظل رهين ثلاثة شروط متلازمة، أولها عدم إفراغ الطعن من مضمونه عبر تعقيد المساطر أو إطالة الآجال أو إقرار تحصينات تشريعية مقنعة تفرغ الحق من محتواه. وثانيها تحقيق توازن دقيق بين ضمان الحق في الدفع ومنع التعسف في إستعماله، وهو ما يبرر منطقيا مقترحات فرض رسوم قضائية معقولة وتحميل خاسر الدعوى المصاريف، وذلك تفاديا لتحويل هذه الآلية إلى أداة لتعطيل العدالة أو إطالة وتمطيط أمد النزاعات بسوء نية. أما الشرط الثالث فيتعلق بترسيخ ثقافة دستورية حقيقية لدى القضاة والمحامين والمتقاضين، تجعل من الدفع بعدم الدستورية وسيلة إستثنائية وجدية لحماية الحقوق، لا مجرد إجراء شكلي أو ورقة تكتيكية في النزاع.
وإذا ما تم الأخذ بملاحظات نادي قضاة المغرب في صيغتها العميقة، فإن المغرب قد ينتقل فعلا من مرحلة دستور متقدم بنصوص مؤجلة إلى مرحلة التفعيل الحقيقي للرقابة الدستورية اللاحقة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويحد من التضخم التشريعي غير المنضبط، ويؤسس لأمن قانوني قائم على إحترام الدستور لا على تحصين النصوص.
ختاما، ما عبر عنه نادي قضاة المغرب لا يمكن إختزاله في كونه مجرد إعتراض تقني، بل هو إعلان غير مباشر عن نهاية زمن التشريع غير القابل للمساءلة. إنها لحظة إعادة الإعتبار للدستور كمرجعية عليا، وللقضاء كحارس فعلي لقواعده من أي خرق أو مساس. ليبقى السؤال وفي خدم كل الدعوات الحقوقية المماثلة لما جاد به نادي قضاة المغرب، هو هل سيلتقط المشرع هذه الإشارة التاريخية ويحولها إلى فرصة حقيقية لتقوية دولة القانون، أم سيعيد إنتاج منطق التحصين والتأجيل؟ في الجواب عن هذا التساؤل يتحدد مستقبل الدفع بعدم دستورية القوانين، ومستقبل الثقة في الإصلاح الدستوري برمته.
د/ الحسين بكار السباعي
محام بهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون.
مقبول لدى محكمة النقض.