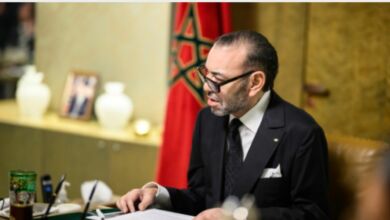وقوع الشر والبلاء في فلسفة الوحي…بين كسب الإنسان والقضاء والقدر

الدار/ خاص
تزامنا مع أزمة فيروس “كورونا” المستجد “كوفييد19” التي تجتازها بلادنا، تتطرق الدكتورة فاطمة الزهراء الناصري، الأستاذة الباحثة المؤهلة بمركز “الدراسات القرآنية” التابعة للرابطة المحمدية للعلماء، لمكانة الشر والبلاء في فلسفة الوحي، بين كسب الانسان والقضاء والقدر، مؤكدة أن فلسفة الدعاء من خلال الوحي لا تقتضي أن هناك علاقة شرطية بين دعوة المؤمن وإجابة الله جل في علاه، ولعل الكفيل برد مجموعة من الأمور إلى نصابها بخصوص هذا الموضوع هو تقديم التصور القرآني لأنواع الدعاء التي أوردتها في ثنايا هذا الموضوع.
تناولت هذا الموضوع من مدخل مقاصدي بالاعتماد على منهج التعليل، كأحد أهم الطرق المنطقية الجدلية في القرآن الكريم، لأن الإنسان جبل على الفضول المعرفي اتجاه الأسباب والعلل، وهو منهج محوري في مناقشة الكثير من القضايا العقدية؛ منها ما يسمى: “معضلة الشر والألم”، انطلاقا من السؤال الآتي: لماذا تقع الشرور والبلايا إذا كان الله رحيما بالخلق؟ ولماذا لا تمتد يده الرحيمة لإقبار الآلام ونشر السعادة والرخاء في الأرض؟
حتى أن انطونيو فلو antoniyo flo وهو أشرس ملحد انتهى إلى وجود إله في العصر الحديث يقول: “إن أحد الأسباب المبكرة لتحولي إلى الإلحاد كان مشكلة وجود الشرور في العالم، فما زلت أذكر المسيرات الهادرة في بافاريا، والتي تتوعد المعادين للنازية بالهلاك، ارتسمت هذه المشاهد في عقلي في فترة صباي وظلت بكل ما تحمله من كره تمثل تناقضا مع ما تربيت عليه في عقيدتي من أن “”الله محبة” إذ كيف يسمح من يحبنا بهذه الشرور”.
لكن قبل السؤال الغائي لا بد من سؤال الحد والتعريف، أي قبل أن نتساءل عن غاية وجود الشر يفترض منهجيا تحديد مفهومه، قد يقال ببساطة: هو ضد الخير، لكن الخير بالنسبة للبعض ليس هو الخير بالنسبة للآخرين، لأن “الشر” من المفاهيم الأدبية والأخلاقية، وهو مفهوم معياري يتحدد بحسب المرجعيات، ويختلف باختلاف الأهداف والدوافع الذاتية، وقد تناولت كل من مباحث فلسفة الوجود والأخلاق. موضوع الشر والخير بما يفيد بأن العقل الإنساني يظل مغالطا ما لم يؤطره منظور كلي محايد وشامل لتحديد مثل هذه المفاهيم المعيارية، وهو ما لا يمكن تحصيله إلا من خلال مرجعية الوحي؛ معيار الموضوعية.
ولذلك فالمؤمن يرى أن الشر الأكبر هو جحود الوجود الإلهي، وما لذلك من تبعات كتأليه المادة والإنسان؛ حيث أدى تأليه المادة إلى التطاحن الدموي لتوسيع الممتلكات، فدُمر الإنسان والطبيعة معا، وأدت فلسفات تأليه الإنسان إلى خلق أنانية مطلقة؛ سعى جراءها الإنسان إلى استعباد أخيه، فنشبت الحروب ودمرت الطبيعة والإنسان معا، وهو الوضع الذي يشهده السياق الكوني المعاصر من تسلط الكثير من القوى الاقتصادية والسياسية التي تحركها فلسفات المادة.
والسؤال المحوري في الموضوع هو: ما هي مسؤولية الإنسان بخصوص ما يقع في نفسه ومجتمعه والكون عامة من شرور؟
من السهل إقناع الفريق الفلسفي الإنسانوي، بأن البشر هو المسؤول بمقتضى حريته عن ما يحدث له ولأخيه الإنسان من الشرور، في حين يحتاج الموضوع إلى جهد كبير لإقناع فريق من المسلمين بذلك، مع وضوح الأدلة على أن حدوث الشر هو من كسب الإنسان، قال سبحانه: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم/40] والفساد هو كل اختلال واقع في المجال الصحي أو البيئي أو غيرهما؛ من ذلك ما تعرفه الأرض من احتباس حراري وتسمم الشواطئ وثقب الأزون وانتشار الأوبئة والفيروسات… وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني على الله تعالى في دعاء الاستفتاح بقوله: ﴿لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت﴾[4]، فتعالى سبحانه عن نسبة الشرّ إليه، لكن سنة الجزاء والعقاب لن تستثني أحدا من المفسدين يوم الحساب ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة/8-9] ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [غافر/16] خيرا أو شرا.
وهذا لا يعارض إرادة الله المطلقة التي تحكم حركة الوجود، لأنه سبحانه بقدرته وإرادته خلق سر الإرادة التي تحرك الإنسان، لذلك لا يتصور أن تكون إرادتك الحرة الممنوحة لك أيها الإنسان، معارضة لإرادته المطلقة سبحانه، وقد حاولت الإجابة عن السؤال أعلاه – والذي يتشابك مع موضوعات عقدية كالقضاء والقدر والأسباب والمسببات والجبر والاختيار والخير والشر – بمنهج بعيد عن التعقيد الكلامي وعن تطرف القدرية وتخلف الجبرية، باستبطان المنهج السني الأشعري القائم على إرادة الله المطلقة التي يتحرك تحتها الإنسان بحرية، بمقتضى سر الإرادة الممنوحة له من الله تعالى، والتي جعلت الإنسان مسؤولا عن كسبه في كيفية توظيف الأسباب المسخرة له أيضا بإرادة الله وتقديره.
ولاستيعاب الموضوع من منظور فلسفة الوحي، لابد من رسم صورة متكاملة للجواب عن السؤال السابق؛ حول مسؤولية الإنسان بخصوص ما يقع في نفسه ومجتمعه والكون عامة من شرور، وذلك من خلال خمس مداخل كالآتي:
المدخل الأول: طبيعة قانون الاجتماع الإنساني حسب السنن القرآنية. المدخل الثاني: طبائع الإنسان ومسؤوليته في توجيه حركة فعله نحو قبلة الخير أو الشر من منظور الوحي. المدخل الثالث: حدود الإدراك البشري للفيصل بين الخير والشر من منظور الوحي. المدخل الرابع: التعامل الأخلاقي فيما بعد حصول تجربة الألم من منظور الوحي. المدخل الخامس: هل يستجيب الله تعالى دعاء المؤمنين به لرفع البلاء والألم؟
وفيما يأتي تفصيل القول في هذه المداخل لاستبانة وجه الحق فيما سمي”معضلة الشر والألم”:
1- طبيعة القانون السنني للاجتماع الإنساني من منظور الوحي:
قدر الله تعالى للاجتماع البشري-كما للكون- أن يسير وفق سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ومطردة لا تتوقف ولا تتخلف وعامة لا تنتقي ولا تحابي، يؤدي السير وفقها إلى التوازن والنماء، ويفضي الإخلال بها إلى الفساد المفضي إلى وقوع الشرور والبلايا والآلام التي طالما تساءل الإنسان عن مبعثها.
والسنن الإلهية هي القوانين الحاكمة قدرا في العباد التي تجري باطراد وثبات وعموم، وهي إما كونية أو اجتماعية فالسنن الكونية: هي التي تتعلق بالأشياء والطبيعة والظواهر المادية، والسنن الاجتماعية: هي العادة المتبعة في معاملة الله تعالى للناس بناء على أعمالهم، والفرق بينهما؛ أن السنن الأولى قهرية، والثانية من كسب الإنسان، فقانون التجمد في الماء عندما يبلغ درجة معينة من البرودة قانون قسري بجعل الله تعالى، لكن سنة التغيير الحضاري الذي ينطلق من تغيير الأنفس، يعود إلى كسب الإنسان بتوجيه حركته في اتجاه قبلة التغير نحو الأحسن، فالفرق هو اختلاف المنطلق؛ فإما قانون قسري في ظواهر الكون أو إرادة حرة في حركة الإنسان ضمن نسقه المجتمعي، وأما الجامع فقيامهما على قانون حصول المعلولات عند وجود عللها؛ فدرجة برودة معينة يساوي التجمد، وتغيير الأنفس إصلاحا يؤدي إلى تغيير الحضارات رقيا ونماء، وهكذا.
إن علم السنن يمكن توظيفه في بيان أصول التعامل مع التاريخ البشري وفهم حركته؛ لإعمار الأرض واجتناب المسالك التي تفضي إلى المهالك، لأن وقوع الشر من كسب الإنسان حال مصادمته لمقتضى هذه السنن، كما أن إغفال العلم بها سبب حالة من السلب والتواكل، وبرر عقيدة الجبر والإرجاء لتعطيل قانون السببية ورفع يد الإنسان عن كل ما يقع من شرور وخراب وآلام، في كل من العالم الإنساني أو الطبيعي، ولكن حتى عندما يقع الشر لا يجوز من ناحية السنن “الاستسلام له وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز، والله تعالى يلوم على العجز”[7]، ومن هذه السنن ما يأتي:
- سنة التغيير الاجتماعي والحضاري:
وهي عمود الأمر في باقي السنن الاجتماعية وذروة سنامها، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل لتغيير الأنفس والمجتمعات، وإخراجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، ومما يدل نصا على مسؤولية الإنسان عن التغيير قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد/12]، وقوله تعالى:﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنفال/54].
والتغيير هو انتقال وتحول من وضع إلى وضع آخر، أي التغيير نحو الأحسن أو العكس؛ حيث قضى الله تعالى أنه لا يغير واقع مجتمع حتى يبدأ أفراده بتغيير ما بداخل أنفسهم من عقائد ومفاهيم وأفكار وأخلاق، ويصلحوا أحوالهم وأوضاعهم، فيغير الله تعالى حينئذ ما بهم.
- سنة التداول الحضاري:
وهي سنة تحكم حركة الحياة وحركة التاريخ، وتتمثل في نظام التعاقب والتناوب الحضاري ودليلها قوله تعالى: ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران/140].
- سنة التدافع الحضاري:
أصلها قوله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين )، وقوله سبحانه : ﴿وَلَوْلَا دفَاعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ﴾ [الحج/38].سنة النصر والتمكين: وهي لا تكون إلا بعد سنة أخرى؛ وهي سنة الابتلاء والتمحيص، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران/141]، والأدلة من كتاب الله على هذه السنة كثيرة وغزيرة منها :قوله تعالى: ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾[محمد/8]، وقوله: ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ﴾ [الحج/38].إن القرآن الكريم بتأكيده على اطراد السنن الكونية والاجتماعية، يبين أن الكون والاجتماع لا يقومان على الصدفة والعشوائية في العلاقات، وإنما تقوم العلاقة فيهما على منطق العلل والمعلولات[8] ، المستخلص بمنهج الاستقراء والملاحظة والتجربة، والمفضي إلى الاطراد والتتابع وعدم التخلف.
وهذا ما يدل على أن الأسباب عوامل محايدة يمكن تسخيرها خيرا أو شرا للسعادة أو للشقاء، بقدر توافقها مع السنن الإلهية في الكون والاجتماع أو مصادمتها لها، والكائن الوحيد المخول له تسخير هذه الأسباب وفق السنن أو عكسها، وبإرادته الحرة في توجيه حركته نحو قبلة الخير أو الشر هو الإنسان، وبالتالي فهو المسؤول عن كل الآلام والشقاء والشرور التي ترتكب في حقه وفي حق كل الموجودات.
2- مسؤولية الإنسان: التوفيق بين طبائعه والتوجه نحو قبلة الخير
تحدث العلامة رمضان البوطي رحمه الله تعالى عن طبيعة الإنسان ككائن مزود بأخطر الصفات والملكات في إطار سنة الابتلاء والتمحيص؛ وتتجلى خطورة هذه الصفات في أنها سيف ذو حدين؛ زود بها من أجل مهمته الاستخلافية والتعميرية في الأرض، ومنها: العقل وما يتفرع عنه من العلم والإدراك، والأنانية وما يتفرع عنها من النزوع إلى التملك، والقوة ومقومات التدبير وما يتفرع عنها من النزوع إلى السيطرة والعظمة والجاه، كما بث فيه مجموعة من العواطف والانفعالات مثل الحب والكره والغضب؛ وهي صفات يمكن أن تأتي بالتنظيم العميم للكون والخير الوفير للإنسان، ويمكن أيضا أن تأتي بالشر الوبيل، والفوضى الهائلة، وتورث الإنسان الشقاء.
ومصدر خطورة هذه الصفات أنها في حقيقتها ليست إلا صفات الربوبية؛ فالعلم والقوة والسلطان والتملك والجبروت، كلها مقومات للألوهية وصفات للرب جل جلاله، ولذلك سماها الله تعالى بالأمانة فقال: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْامَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْانسَانُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب/72] –[9] ، وكل هذه الصفات التي مُنحها الإنسان عندما لا تتجه إلى قبلة الخير، فإنها ستتجه بالحركة حتما إلى الشر.
لكن كيف يستطيع الإنسان توظيف هذه الصفات في التوجه إلى الخير بدل الشر؟ يجيب العلامة أحمد عبادي حفظه الله تعالى عن هذا السؤال من خلال التأسيس لنظرية ذات بعد وظيفي، تفيد ضرورة التكامل بين ثلاثي: “الحركة” و”الوجهة” و”القبلة”، مما يسر استبانة وجه الحقيقة في العديد من القضايا، يقول: “سياقة سيارة إذا اقترنت بها وجهة غير مستبصرة قد تجعل منها حركة قاتلة رغم فاعليتها، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد في المجال الإنساني، فالحركة والوجهة ــ وإن تكاملتا ــ فإن تكاملهما إلى غير قبلة معروفة مأمونة العواقب سوف يجعل منه تكاملاً عابثًا سرعان ما يغيض”[10].
ومن أهم الشواهد على هذا الكلام قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة/148]، فهذه الآية الكريمة من الكليات العامة الحاكمة في بيان المنظور القرآني للوجود والحياة، يتم الاستشهاد بها في سياقات مختلفة لوجهات متعددة، وهي في سياق موضوعنا شاهد قوي في بيان مسؤولية الكسب الإنساني في حركة الوجود، يتجلى هذا من خلال تدبر مفردات الآية كالآتي:
﴿ولِكُلٍّ﴾؛ للمخلوق العاقل أي الإنسان، لأن باقي الموجودات غير معنية بالمسؤولية في القيام بالحركة الحرة في اتجاه قبلة ما، فقد تحددت قبلتها سلفا وقهرا لقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْارْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِين﴾ [فصلت/10]، وقوله: ﴿وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾؛ أي هدف يتجه إليه تفكيرا قبل أن ينفذه حركة، لأن الاتجاه إلى حركة معينة ينطلق من تصميمها النظري المجرد، ﴿فَاسْتَبِقُوا﴾؛ إشارة إلى ضرورة التدافع الحضاري باعتباره سنة اجتماعية، ﴿ الْخَيْرَاتِ﴾؛ وهي القبلة التي يجب أن تتجه إليها حركة الكسب الإنساني، ويتحقق ذلك بالانسلاك في موكب الساجدين، وملازمة الصالحين[11].
أي أن الكفيل بتوجيه الحركة الإنسانية نحو الخير هو تحديد وجهتها نحو قبلة الخير، والتسابق إليه بعد التخلية من كل العقبات الساحبة إلى الشر، وهو ما عبر عنه حفظه الله تعالى بقوله: “فالإنسان لا يتمكن من السجود إلا بقدر تخلصه من مختلف السجون المحتوشة له، كالتخلص من سجن نفسه بالمجاهدة والتزكية، ومن سجن محيطه بالتوكل، ومن سجن العقائد والمفاهيم الباطلة بالإخلاص، ومن سجن الأشياء بالتوق إلى الآخرة المنتج للزهد…”[12].
ولذلك فالإنسان في منظور الوحي يتحدد بما ما كسب وما سعى وما عمل، وهو ما عبر عنه الدكتور أحمد عبادي بقوله: “هنا يصبح العمل عنوان حالة النفس، ويصبح هو المحرك لها… إلى درجة يمكن فيها اختزال الإنسان في عمله، ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ اهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾[هود/45-46] [13].
3- حدود وقوع الاستثناء في قانون السببية الكوني
لنفرض أن الإنسان سار وفق سنن الله في الخلق، ولم يتخلف عنها ولم يتحرك عكس اتجاهها ولم يعارضها بأي شكل من الأشكال، ووجه كل حركاته نحو قبلة الخير، هل سيختفي “مسمى الشر” من الحياة؟ أو بالأحرى ما يراه الإنسان شرا؟ بمعنى ما هي حدود الإدراك البشري للفيصل بين الخير والشر والقدرة على معرفة مقاصد الأمور وإدراك مآلات الأحداث في منظور القرآن؟
من القصص القرآنية التي تلعب دورا مهما في التأسيس للاستثناء في مفهوم الشر في الرؤية القرآنية، قصة موسى عليه السلام مع الخضر؛ الرجل الصالح الذي تجلت من خلاله أحداث الخير والنفع في صورة الشر والأذى؛خرق السفينة وقتل الغلام وهدم الجدار ﴿فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا امْرًا﴾[الكهف/70]، ﴿فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا﴾ [الكهف/73] أجاب الرجل الصالح الذي تكشفت له المآلات: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ [الكهف/66-67]، فالعبد الصالح “إنما تخطى بعلمه حدود الزمان والمكان الذي يعيش فيه الناس، إلى النتائج النهائية التي تؤول إليها مجريات الأمور، فكانت هذه التصرفات هي التي يجب أن تقع، وأن وقوعها على تلك الصفة، هو الخير كل الخير”[14].
نفهم من هذا أن هناك حالات يعجز فيها الإنسان -بمعاييره المحدودة- عن إدراك مآلات التدبير الإلهي لسير الأحداث على الأرض، عندما يتمظهر الخير في صورة الشر، والشر في صورة الخير؛ وحجة الله البالغة في ذلك قوله: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة/214]، وهو مقتضى رحمة الله التي قد تتدخل لتعطيل قانون السببية الكوني أو تغيير مساره وتوقيف اطراده.
لكن مثل هذه الوقائع لها حجمها بالنسبة للسير العام للأحداث على الأرض، والتي تخضع-أصالة- لقانون الأسباب والمسببات، فنحن بصدد وضع يشكل الاستثناء ولا يمثل السنة الكونية العامة المطرد.
فإذا كان لدينا ما لا يحصى من حجج الله البالغة على وجوده، وأن قصده الأسمى هو إسعاد البشر، عن طريق تسخير كل الكون له، وجعله المخلوق الأكرم، والأذكى، والأكثر حرية، والأكثر قوة وتحكما…، فهذه الاستثناءات المتعلقة بحدوث الشر هي لغة أخرى للتعبير لم يفهمها البشر، كما لم يفهموا أشياء كثيرة تتعلق بذاته سبحانه، وبالكون من حولهم.
لكن قد يدرك مغزاها بعض المتألمين فنراهم في صورة المتألم وهم في بحبوحة السعادة، لذلك فتجربة الألم والراحة تجربة خاصة، فكما لا يمكن الحكم على سعادة الإنسان من مظاهره، كذلك لا يمكن الحكم عليه بالألم والشقاء من مظهره.
4- التعاطي الأخلاقي مع تجارب الألم، مثال: “الموت”.
إذا كان ما سبق هو محاولة في فهم أسباب وقوع الشرور والبلايا والآلام، فماذا عن ما بعد حصول ذلك لبني الإنسان؟ أي ما هو الموقف المفترض اتجاه الآخر المتألم؟، هل هو شرح الأسباب ووسائل التفادي؟ كلا.
المتألم يحتاج فقط إلى لغة الوجدان لا إلى لغة المنطق والتفسير، يحتاج إلى المشاركة النفسية، لذلك فمع أن الموت سنة كونية حتمية، إلا أن القرآن العظيم يسميها “مصيبة” ﴿فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾[المائدة/108] لا باعتبار حقيقتها، وإنما باعتبار وقعها النفسي على الإنسان الفاقد، وهو مقتضى مقصد الإسعاد الذي بني عليه الوحي مما يقتضي التعاطف مع المتألم.
فمع أن الموت في بعض صوره هو من تجليات رحمة الله بالإنسان المتوفى: ﴿وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [النحل/70]؛ فالموت أرحم من العيش بعد أرذل العمر، ولكن باعتبار تجربة الفاقد اعتبرها الله تعالى مصيبة، ولم أقف على أحد من المفسرين انتبه إلى هذه اللطيفة من لطائف إشارات القرآن.
ومما يعزز هذا المعنى قول الرسول الأعظم وحدة قياس الكمال البشري “اصنعو لأل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم”[15] ، ولم يمنع التعبير عن الألم بالبكاء فقال عندما مات ابنه إبراهيم: “العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون”[16]، ولذلك ليس هناك نصوص تدعو إلى وعظ الناس وهم يمرون بتجربة ألم معينة كالفقدان، وإنما هناك دعوة لصناعة الطعام، تعبيرا عن التعاطف والإحساس المشترك بالحزن كأقل ما يمكن بذله، وهي فلسفة عميقة في التعامل مع الألم الإنساني، تتوسل بالفطرة والضعف المتأصل في الإنسان، وتدعو إلى مشاركة بدل الوعظ.
5- هل يستجيب الله تعالى دعاء المؤمنين به لرفع البلاء والألم؟
فلسفة الدعاء من خلال الوحي لا تقتضي أن هناك علاقة شرطية بين دعوة المؤمن وإجابة الله جل في علاه[17]، ولعل الكفيل برد مجموعة من الأمور إلى نصابها بخصوص هذا الموضوع هو تقديم التصور القرآني لأنواع الدعاء التي هي في تقديري كالآتي:
- دعاء العبادة
وهو التعبير عن اعتقادنا في صفات الله تعالى وإثباتنا لها: فنطلب المغفرة من الغفور والرحمة من الرحيم، والشفاء من الشافي، والعفو من العفو، والرزق من الرزاق، والحكمة من الحكيم، لذلك يؤكد أهل الذوق والإشارة أن البلاء الذي يجعلك تلح على الله بالدعاء هو عطاء وإن أوجعك.
- دعاء الطلب أو الدفع
وهو نوعان:
– الطلب المتواكل
قد يحتاج الداعي عطاء أو حماية وبيده توفيرها، ثم لا يتحرك في اتجاه أسباب الفعل الذي يتحقق به العطاء والحماية، في تعطيل لقانون الكون القائم على السبب والنتيجة، ظانا أن مجرد اتجاهه إلى القبلة الصحيحة في الدعاء “الله جل جلاله”، وبدون أي حركة، يجب أن تترتب عليه نتيجة شرطية هي إجابة الدعاء، وهو خلل تصوري بخصوص إرادة الله الأزلية، التي تعلقت بوضع الكون على سنن معينة، يؤدي الإخلال بها إلى فساده وتقهقره، ولذلك قيل: ترك الأسباب من سوء الآداب مع الله.
– الطلب الاضطراري للعطاء أو دفع البلاء
تتضح صورة هذا النوع من الدعاء بالجمع بين الآيات المتعلقة بموضوعه بمنهج تفسير القرآن بالقرآن، ومن الآيات الواردة في الموضوع قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر/60]، وقوله سبحانه: ﴿أمن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾[ النمل/64]، عندما نحمل الآية الأولى على الثانية نفهم أن الله تعالى يجيب الداعي المضطر، ومعنى الاضطرار هو العجز عن القيام بالأسباب أو استنفاذها دون حصول النتائج، “فالمضطر إذن لا بد أن يُجيبه الله، فمن قال: دعوت فلم يُستجب لي، فاعلم أنه غير مضطر، وليست كل ضائقة تمر بالعبد تُعد من قبيل الاضطرار”[18].
ولهذا فملايين من المسلمين اليوم يدعون الله في الصلوات جماعة ويدعونه أفرادا لتحرير بيت المقدس ونصرة المسلمين، ولا يستجاب لهم، لأنهم لم يأخذوا بأسباب النصر والتمكين، ولم يسيروا وفق سنة الله في التدافع التي تمنع هدم بيوت الله من مساجد وصوامع وبيع، وحجة الله البالغة على هذا قوله: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ [البقرة/185]، فمن مقتضيات إجابة الدعاء، الاستجابة أيضا لله بالسير وفق قانونه الكوني القائم على الحركة في اتجاه تفعيل الأسباب.
وهو”أعدل وضع يمكن أن يعيش فيه الإنسان مؤمنا بنفسه، ومؤمنا بربه، مؤمنا بقدرته المحدودة، التي يعمل في حدودها، ومؤمنا بقدرة الله التي لا تحد، يمد إليها يده عندما يستنفذ قوته، عندئذ يكون أهلا لأن يستنجد فينجد، ويدعو فيجاب”[19].
- دعاء المعجزات والكرامات:
المعجزات من عطاءات النبوة لطبيعتها الوظيفية في الإقناع، والكرامات بالنسبة لسائر أولياء الله تأتي من أن الطاعات العظيمة يقابلها عطاءات عظيمة، وهي فكرة تنسلك أيضا ضمن قانون الأسباب والنتائج الذي اقتضت إرادته سبحانه وتعالى أن يسير الكون وفقها، ولذلك فإرادة الله وقدرته فوق جميع قوانين الكون والاجتماع في الأسباب والمسباب؛ لأنه تعالى خالق الأسباب والمؤذن بحدوث نتائجها.
التوظيف المنهجي لهذا التقسيم:
إن ما يقع من خلل في علاقة الإنسان بالله دعاءً، ناتج عن رغبة هذا الأخير-جهلا- في أن يتحول من داع متواكل، إلى داع صاحب كرامة، يعني أن يتحول من سلوك مختل يقوم على تعطيل الأسباب، إلى علاقة ولاية تقوم على العطاء الاستثنائي، بالقفز على الوسط الذي يمثل السلوك الأصل المبني على قانون الأسباب والنتائج.
وهذا النوع من الخلل في التفكير والسلوك أدى إلى خمود الحركة على مستوى العلاقة بالكون القائم على الحركة الدائمة لقوله سبحانه: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾[الأنبياء/33]، وأدى إلى الخمود على المستوى الاجتماعي اقتصادا وسياسة وتربية وغيرها، والاجتماع لا يقبل التوقف أيضا شأن الكون لقوله عز وجل: ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾[المدثر/37] ولا وجود لخيار التوقف.
وأرى تساوقا مع هذا السياق الصحي العالمي الموبوء، أن أختم هذه الصفحات بقول الرحمان الرحيم على لسان الجن: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ ارِيدَ بِمَنْ فِي الارْضِ أَمْ اراد بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن/10].