الثقافة الديمقراطية بالمغرب… دَوْر الثَّقافة، دَوْر المُثقَّفِين [2]
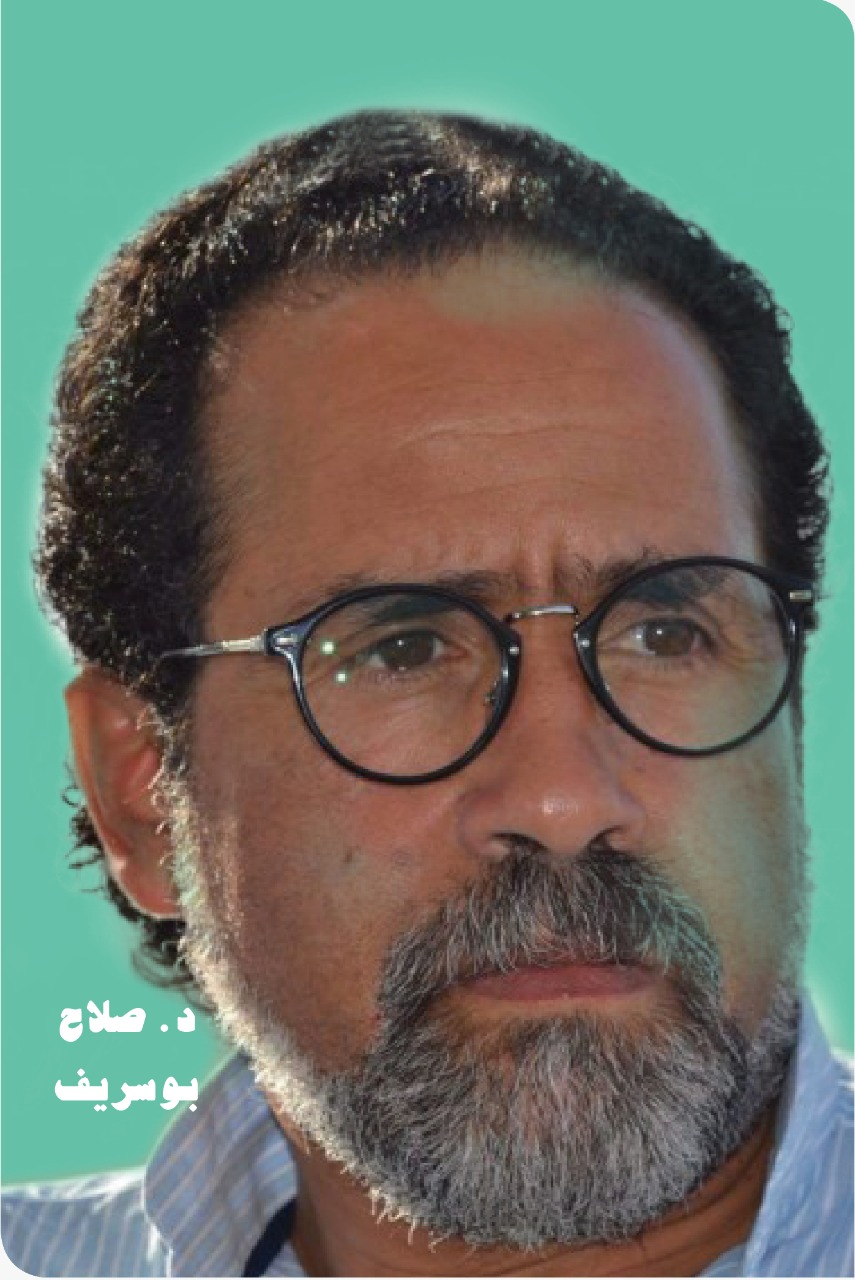
صلاح بوسريف
في هذا المنعطف، بالذات، سعى السياسيون إلى سحب الديمقراطية من يد المثقف، وإلى منعه من وضعها في سياق فكره المُتحرِّك، المُنْتَقِد، الشَّاكّ، وفصلها عن الثقافة، لتصير، تربية تجري بالقَهْر، أي باعتبار كل النَّاس، وليس طبقة واحدة منهم، غير مُؤَهَّلِين للحرية، لأنها ستصير في يدهم فوضى، إذن فالدولة، هي من ستتكفَّل بوضع القوانين، وبقراءتها وتأويلها، وبإعادة صياغة بنودها، أو إجراء تعديلات عليها، وفق ما تراه هي، لا ما يراه المثقف، لأنَّ المثقف بالنسبة لها، ينتمي من حيث المبدأ، إلى الطبقة الأولى، لأنه فوضيّ بطبعه، وهذا ما سعَتْ الدولة أن تَشْرَحَه للناس في مُحاكَمَتِها لسقراط، دون أن تنتبه إلى أنَّ سقراط في دفاعه عن نفسه، حاكم الدولة، وأدانها، رغم اعترافه لها بالحق في تطبيق الشَّرائع والقوانين، وأنه سيقبل بما يصدر عنها من أحكام.
المثقف مُشَوَّشٌ، قَلِق، دائم التفكير، وفُضوليّ، يَحْشُر أنفَه في كل شيء، يتجوَّل في المدينة لا لِيَتَنزَّه، بل ليرى الناس ويستمع إليهم، فهو لم يعُد مسموحا له أن يُحاوِرَهُم، لكنه يُنْصِت، ويرى، ويُلاحظ، ويسأل، وحتَّى الجامعة التي كان فيها إلى وقت قريبٍ، يُدْلِي فيها بقلقه، أُفْرِغَت من هذا المعنى، وصار الجواب هو الأساس، لا السؤال، وفي تكريس ثقافة الجواب، يتم تكريس اليقين، والمُسلَّم به، وينتفي الوعي النقدي، كما ينتفي الإبداع والاختلاق، لِيَتَسَيَّدَ التكرار والاستعادة والاجترار.
حين نتأمَّل العنوان في علاقتِه بنا نحن المغاربة، فهو يكاد يكون غير وارد، لأنَّنا نتحدَّث عن الديمقراطية، كما نتحدَّث عن المُعَيْدِيِّ، فأن تسمع به خيرٌ من أن تراه، كما جاء في المثل العربي الدَّارج. صحيح أننا قطعْنا شوْطاً ما في المسار الديمقراطي، منذ أطلقت الدولة، لا المثقف، شعار «المسلسل الديمقراطي»، على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وأنَّ ديمقراطية اليوم، ليست هي ديمقراطية الأمس، وأنَّ من لم يكونوا يحلمون بالسلطة من الأحزاب والأفراد، وصلوا إليها، لكن الديمقراطية ليست هي الانتخابات، والمجالس البلدية، والبرلمان، وغيرها من المؤسسات التي هي من تعبيرات الديمقراطية، أو ما يدُلُّ عليها، بل إنَّ الديمقراطية، في جوهرها، تربية وثقافة، وهي سلوك، وهذه التربية والثقافة، وهذا السلوك، يبدأ من الأسرة، والمدرسة، وفي الإدارة، وفي الشارع، وفي استقلالية القضاء، وحرية القاضي في الاحتكام إلى القوانين، لا في تكييفها مفق منظور زيد أو عمرو مهما كانت صفتُه، صحيح أن القانون أسمى من الجميع، لكن، ما لم يتأسَّس هذا القانون على التربية، ويصير ثقافةً، وتعود للمثقف كلمتُه التي بها يتأمَّل المدينة، ويُحاوِرُها، ويحرص على تأجيج العقل في الإنسان، فإنَّ الديمقراطية لن ترقى إلى معنى الثقافة، وبالتالي، ستبقى مجرد شعار، أو بيتٍ دون ساكن، وفي هذه الحالة لن يكون اسم البيت ما يليق به، لأنَّه مُجرَّد بناء، لا عُمْران ولا مُقيم فيه.
ولعلِّي أعود إلى مفهوم العُمْران هنا، لأُشِيرَ إلى أنَّ الدول لا توجَد إلا بالعمران، أي بالمديتة، وبالمجتمع، أعني بالإنسان. وقد كتبتُ مراراً أعتبر أن مفهومَنا للتنمية البشرية مغلوط، لأنَّنا نفكر في البنايات، ولا نفكر في الإنسان، في تكوينه، وتعليمه، وتأطيره، وتربيته، وتثقيفه، لأنَّ الإنسان بهذا المعنى، هو ساكِنُ المدينة، وهو من يُساهِم في عمارتها، لا في خرابها. وأعود، هنا، أيضاً، إلى دور الثقافة في العمران، أي في بناء الإنسان. فما لم نضع الإنسان نُصْب أعيُنِنا، سيبقى العمران ناقصاً، والمدينة ستكون مُهدَّدَةً بالتَّلَف وبالفوضى، وهذا ما نرى عليه مدننا، التي تتهالك، وتتراجع، وتتنشر فيها قيم الفوضى واللاقانون، رغم وجود القوانين.
الحاضر، إذن، هو هذا، هو وجود مؤسسات ومظاهر وأثر للديمقراطية، لكن الحياة الديمقراطية لا تظهر في المدينة، في سلوك الناس، في القضاء، في الإدارة، في المدرسة، في الأسرة، في الحوارات التي تجري في البرلمان، في الإعلام، الاستفراد بالرأي والاستقواء، ليس سلوكاً ديمقراطياً، لأن الديمقراطية هي حوار، وإنصات، وإيمان بالاختلاف، وقبول للنقد، بالرد عليه بالحُجَّة والبرهان، واستمداد الأفكار من المعارضين والمُنْتَقدِين قبل التابعِين والمُوالِين، كلما كان رأي المُعارض أو المُخالِف، سديداً، يخدم الجميع، ويُفيد البلاد والعاباد. هذا ما نجده يجري في الديمقراطيات التي ربطت الديمقراطية بالتربية والثقافة، واعتبرت الإنسان هو مدار الديمقراطية، وليس القوانين والشرائع الموجودة على الورق، لأنَّ القوانين نفسها إبداع بشري، وهي وضعية، تسير على وتيرة المجتمعات والوقائع والأحداث.
المستقبل، أو الرِّهان، هو رهان على الثَّقافة، وعلى التربية، وعلى التعليم، وعلى الإعلام، وعلى الإسان، وليس على أصْداء وآثار الديمقراطية، وأصداء وآثار الثقافة، وأصداء وآثار التربية، وغيرها من الفضاءات والعناصر والخواصّ التي بدونها ستبقى الديمقراطية تجري فوق، ولا تنزل إلى الشارع، مثلما كان أنزلها سقراط، المثقف، إلى الشارع، رغم أنَّه كان ضحية عَسْف الدولة التي عاقبتْه على تعميم الحق في الثقافة، والحق في الحوار، وفي إبداء الرأي، والقلق والشّك.








