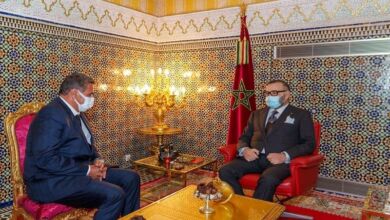الأمن الروحي الإسلامي في زمن الثقافة الرقمية (2/3)

بقلم: خالد حاجي*
من حرب الأجسام إلى حرب الأرواح
ولفهم حقيقة الانتقال من حرب الأجسام والأجساد إلى حرب النفوس والأرواح، ومدى تأثير هذا الانتقال على أمن المجتمعات الدينية الروحي في عالم اليوم، لا بد من وقفة قصيرة مع تطور فنون الحرب وصناعة الأسلحة. في العقد الأخير من القرن الماضي، وتحديدا في سنة 1995م، صدر للزوجين ألفين وهايدي توفلير ( Alvin and Heidi Toffler ) مؤلف تحت عنوان: «الحرب وضدها» ( War and Anti-War )، الذي هو عبارة عن تحليل لظاهرة الحرب عبر العصور ومحاولة لاستشراف مستقبل الصراعات المسلحة على ضوء ما يشهده العالم اليوم من تحولات تقنية وتكنولوجية سريعة. وينطلق الباحثان من فكرة أساسية مفادها أن لكل حقبة من الحقب التاريخية الكبرى نمطا خاصا بها في صناعة الحرب والسلم.
فقد كانت الحرب خلال الحقبة الزراعية الأولى عبارة عن جيوش تُواقِف (من المواقفة، ومثلها المجابهة والمناهضة) بعضها البعض، فيتنادون « أخرجوا لنا شجعانكم »، حتى إذا تشابك المتقاتلون، نتج عن تشابكهم خسارة في الأرواح، غير أن حجم الخسارة يظل محدودا، مرهونا بقوة المقاتلين وشجاعتهم وصلابة سيوفهم وأسلحتهم الفردية. هذا على خلاف الحقبة الصناعية اللاحقة حيث يحصل تساوق بين الإنتاج بالجملة (Mass production) من ناحية، والتدمير بالجملة (Mass destruction) من ناحية أخرى.
ويضيف الباحثان أن الحرب في الحقبة الثالثة سيكون عمادها « الاستراتيجية المعرفية »، هذه الاستراتيجية التي ستعتمد على وسائل تقنية جديدة بإمكانها أن تبطل مفعول الجيوش على الأرض وتكسر شوكتها في السماء. فنحن إزاء جيل جديد من الأسلحة الذكية القادرة على الحد من أهمية القوة العسكرية المادية التقليدية. باختصار، يستفاد من مؤلف الباحثين ألفين وهايدي توفلير أن العالم سيشهد نمطا جديدا في الحرب لم يعرفه من قبل.
وبالفعل، تدرجت فنون الحرب وصناعة الأسلحة، ومعها الاستراتيجيات العسكرية، في التطور حتى بلغت مرحلة أصبح فيها السلاح الافتراضي، كما يوضح ذلك لوكاس كيلو Lukas Kello في كتابه « السلاح الافتراضي والنظام الدولي » ( The Virtual Weapon and International Order ) أكثر تهديدا من السلاح النووي. وتكمن خطورته في إلغائه لعامل الجغرافيا وإنهائه للعقيدة الاستراتيجية التقليدية التي كانت تقوم على حماية حدود السيادة البرية والبحرية والجوية فحسب، وكذلك في إلغائه للحدود بين العسكري والمدني، بحيث أصبح بإمكان الفرد الجالس وراء حاسوب أن يحدث من الخسائر ما لا تحدثه الجيوش الجرارة؛ وفي تغييره لجملة من المفاهيم، كمفهوم «إعلان الحرب» و «زمن الحرب»، بحيث أصبحنا نشهد أفعالا هي مثابة إعلان حرب، كالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية مثلا، لكنها أفعال تقع في زمن السلم، الأمر الذي يربك الحسابات ويخلط أوراق الاستراتيجيين. حتى العدو لم يعد عدوا خارج الحدود، بل أصبح عدوا داخليا، نتساكن معه في فضاء افتراضي، فيفعل فينا ما لا يفعله العدو التقليدي.
لم يكن لهذه المستجدات والتطورات على مستوى الأسلحة أن تمضي دون أن تترك أثرها على الفكر الاستراتيجي؛ ولعل من أبرز أوجه هذا الأثر أنها مَكَّنت لدعاة استعمال القوة الناعمة وبعثت آمالهم في خوض حروب الأرواح والنفوس، بعد انتهاء حروب الاستحواذ على الأرض والجغرافيا. الحاصل أن كتاب جوزيف ناي، عضو إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، عن « القوة الناعمة: سبل النجاح في السياسة الدولية » ( Soft Power: The Means to Success in World Politics, by Joseph Nye ) يؤشر على وجود وعي جديد، في مرحلة ما بعد غزو العراق وأفغانستان، يستحث الولايات المتحدة الأمريكية على الاشتغال على أمن المجتمعات الإسلامية الروحي، وكأننا بأصحاب هذا الوعي يريدون أن يقولوا لنا بأن زمن التدافع المادي من أجل احتلال الأمكنة قد انتهى، حيث أصبح من السهل استباحة حدود البلدان الجغرافية، وأنه قد أصبح من الضروري النفاذ إلى عمق المجتمعات الروحي، الأمر الذي يستدعي أسلحة لطيفة لا قبل للأولين بها.
بالفعل، لم يسبق وأن استُهدف أمن المجتمعات الروحي مثلما هو مستهدف اليوم في زمن الأسلحة الافتراضية. ومن فاته الوعي بهذه الحقيقة فلا شك أنه سيصبح لقمة سائغة في عالم اليوم، لا يملك ما به يصمد في حروب الأرواح. لقد درجت بعض المجتمعات، وضمنها المجتمعات الإسلامية، على التحصن وراء هوية الأغلبية الدينية لضمان تماسكها الروحي؛ ونحن نعلم أن مفهوم « الأغلبية » كان أول مفهوم طالته معاول الهدم المستعملة من طرف القوة الناعمة في زمن الثقافة الرقمية والفضاء الافتراضي.
قديما كانت الجغرافيا عاملا محددا يسمح بالتمييز بين الأقلية الدينية والأغلبية، ويُمكِّن بالتالي من الوصول إلى تسويات وتوافقات تقوم عليها موازين القوى. وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية سلمية، تكون الأقلية مجبرة على الخروج باتجاه أمكنة أخرى تراها أرحم وأنسب لممارسة معتقداتها بحرية. أما اليوم، ونحن نعيش وضع الالتباس على الحدود بين الجغرافيا والعوالم الافتراضية، فقد أصبحت الأقليات تلوذ بهذه الفضاءات، تتحصن داخلها، وهي لا تكترث بالتفاوض مع الأغلبية من أجل احتلال مكانة تحت شمس المجتمع، بل يراودها الإحساس بأنها تطوق هذه الأغلبية من الخارج. لقد دخلنا زمنا افتراضيا انتعشت فيه الأقليات في شكل هجرات خروج من فضاء المجتمع العمومي، باتجاه فضاءات افتراضية يتم فيها إعلان الولاء للعقائد الخالصة من شوائب الاختلاط، المتحررة من عوالق التسويات التاريخية والخصوصيات الثقافية وغيرها. هناك قرائن عديدة تعزز الاعتقاد في أن الفضاء الافتراضي أصبح مثابة فضاء تتربص داخله الأقليات خارج حدود الأغلبية، وأننا أصبحنا نشهد نهاية « الأغلبية ».
يتوجه العالم نحو مجتمعات جديدة تتألف من أقليات متساكنة، تُحكَم من الداخل والخارج على السواء، بواسطة سلطة مائعة خفية تعتمد المعلومة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بمفهوم الديموقراطية إلى « مستوى أعلى ». فبعد أن كانت الديموقراطيا ترتكز على حكم الأغلبية، أصبحت اليوم تتأسس على حكم الأقليات لذاتها، وفق ما يناسب معتقداتها وميولاتها. بفضل الهجرة إلى الفضاء الافتراضي وبفعل التحكم في الخوارزميات والذكاء الاصطناعي أصبح بمقدور كل أقلية أن تكون المنتجة لفكرها الإيديولوجي المستهلكة له في نفس الآن، بعد أن كانت من قبل مجبرة على الخضوع لإملاءات الأغلبية والامتثال لشرعيتها. وعليه، أصبح يتعذر الارتكاز على الأغلبية لحماية أمن المجتمعات، كيفما كان هذا الأمن، روحيا كان أو غيره.
ولعل خير دليل على انهيار الأغلبية هوتفكك الارتباط بينها وبين الفكر الديموقراطي، هذا التفكك الذي أصبح وراء ما يشهده العالم من محاولات عنيفة للعودة إلى هوية المجتمعات الأصيلة، وهي المحاولات التي أصبحت تتخذ شكلا شعبويا-قوميا في السياق الأوروبي مثلا. تنم الدعوة إلى العودة إلى هوية المجتمعات الأصيلة عن الرغبة في العودة إلى ترسيم الحدود بين الأغلبية والأقلية كما هي في الواقع العيني، لا كما هي في الواقع الافتراضي. ويهمنا في سياق الحديث عن الأمن الروحي الإسلامي أن نعرف إلى أي حد ما يزال استدعاء الأغلبية يضمن هذا الأمن، وإذا كان طلب العودة إلى ترسيم الحدود بين هذه الأغلبية والأقلية يكتسي طابعا شعبوياـقوميا في السياق الأوروبي، فما هو الشكل الذي يتخذه في السياق الإسلامي؟