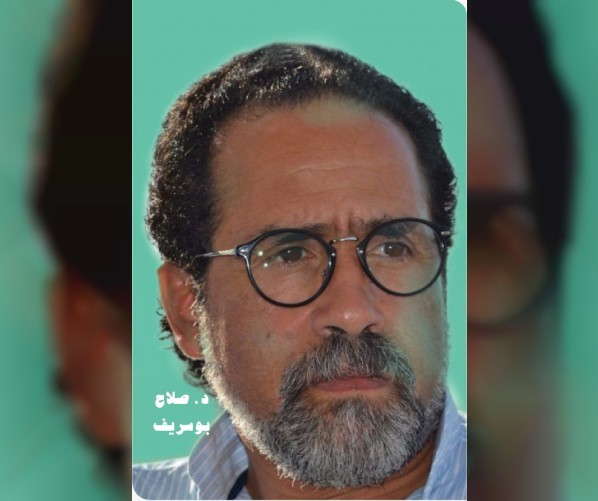
د. صلاح بوسريف
[1] التربية على الديمقراطية
في هذا العنوان، أجد نفسي مدفوعاً إلى فهم الموضوع، قبل الشُّرُوع في الحديث عن ما يَقْتَرِحُه عَليَّ من أفكار، أو ما أنا، مَدْعُوٌّ للحديث فيه:
ـ «الثقافة الديمقراطية بالمغرب، تحديات الحاضر ورهانات المستقبل».
هل الموضوع هو الثَّقافة أم الديمقراطية، قبل الخَوْض فيما يليهما، أم هما معاً، لكن بأي معنى، ووفق أي صيغة!؟ العلاقَهُ بين الصِّفَة والموصوف، فيها التباس، لا تسمح بمعرفة من سيكون الأهم والأوْلَى في الموضوع، أو في حديثنا في هذه الندوة. فحتَّى حين نفترض أن الحديثَ سَيَنْصَبُّ على الثَّقافة في علاقتها بالديمقراطية، أو الثقافة في وضعها الديمقراطي، فنحن سنكون مُجْبَرِين على اسْتِجْلابِ مفهوم التربية، لإعادة تركيب وبناء العنوان، وفق ما يهجس به، في بعض إيحاءاته، ليصير كالتالي «التربية على الديمقراطية»، وحين نستعمل مفهوم التربية، في هذا السياق، فنحن نُعِيدُ إدخال الثَّقافة ضمن العنوان، لكن، بتضمينِها في مفهوم التربية، لأنَّ التربية لا تستقيم، ولا تجري بما تفرضه طبيعتُها، إلاّ بوضعها في ماء الثقافة، أو غَسْلِها به.
يبدو لي أنَّ الموضوع الذي سنُناقِشُه اليوم، هو التربية على الديمقراطية في المغرب، في بُعْدِها الثقافي، أو باعتبارها ثقافة، وما تطرحُه علينا هذه التربية من تحدِّيات ورهاناتٍ.
لم أخرج من جوهر الموضوع، بل فقط، أعَدْتُ تركيبَ وبناءَ الموضوع، حتَّى لا أسمح لنفسي بالحديث عن كُلِّ شيء، دون أن أقولَ شيئاً. لذلك، فأنا أرى أن الديمقراطية، هي فكرة ثقافية بالدرجة الأولى، أو أنَّها كمفهوم، جاءت من الثَّقافة، لا من الطبيعة، وهُنا، لا بُدَّ من استعادة مفهوم المدينة La cité باعتبارها كياناً ثقافياً، قام على الفن، والفكر، والإبداع، وعلى الإنسان. السياسةُ تَلَتْ هذا المعنى، أو خرجتْ منه، لتنفصل عنه، لاحِقاً، ويحدُث الجَفَاء بين الإثنين.
الديمقراطية، في أثينا، كانت فكرة المثقفين، فكرة العقل، فالعقل هو المُشَرِّع، وهو واضِع القوانين، وهذا ما كان ذهب إليه أفلاطون، حين قسَّم الطبيعة البشرية إلى ثلاث طبقات، طبقة يجب أن نفرض عليها القوانين والقواعد من فوق، لفرض النِّظام عليها، لأنها بدون نظام ستَنْشُر الفوضى، وستجعل المدينة بدون ضوابط ولا كوابح، بدعوى الحرية. والطبقة الثانية، هي طبقة تميل، بطبيعتها إلى القوانين، والانضباط للشَّرائع والمُعتقدات، رغم أنها هي ذاتُها عاجزة عن أن تَسْتَكْشِفَ الغايات التي ترمي إليها هذه القوانين. الطبقة الثالة، وهنا يضع أفلاطون إصْبَعَه على الفيلسوف، أو على المثقف، إذا شئنا، رغم أن المفهوم طارئاً وحديثاً، ولم ينحدر من هذا الزمن، وهذا الأخير، أهم صفاته ومواهبه الطبيعية العَقْل.
رغم نقدنا لهذه التقسيمات، ورغم ما قد يتبدَّى لنا فيها ومن وجَاهَة، في بعض الأحيان، فإن ما يعنيني هنا، هو أنَّ أفلاطون، أدرك دور المثقف في التشريع، وفي تكريس الحق، وتنظيم المدينة بالتشريعات والقوانين، لأن المثقف، يبقى، مهما انتقدْناه وعاتبْناه، هو من بيده تفكير مشكلات وقضايا المدينة، وأيضاً حمايتها من الفوضى والظلم، أو التَّسيُّد والاستبداد. فالديمقراطية، في أثينا، ظهرت باعتبارها ثقافة، حين تمَّ تَشْريبها، ولو بالقوة، إلى الطبقة الأولى التي كانت خارج الانضباط لقيم الديمقراطية، أما الطبقة الثانية، فهي مُنْخَرِطَة، بطبيعتها، أي بتربيتها وتكوينها، إلى هذا الأفق الثقافي المديني والحضاري الذي هو مجتمع الثقافة في مقابل مجتمع الطبيعة الذي تنتفي فيه القوانين، أو تكون خارج التربية وخارج العقل، لأن الطبيعة في ذاتها، هي تربية على الاستقواء والغَلَبَة والنفوذ، وهيمنة سلطة الغالب، على ضعف وانتكاس المغلوب.
حين عُدْتُ بالمفهوميْن المُؤَطِّرَيْن للموضوع، إلى أصلهما، فأنا قَصَدْتُ أن أُشِيرَ إلى أن التربية على الديمقراطية، تأسَّسَت في أصلها، باعتبارها ثقافة، ووعياً بشروط الحياة في المدينة، وأنَّ الثقافة هي مُبْتكرات الإنسان من قِيَم وأعراف، وفنون وآداب، ومن علاقاتٍ تقوم على الحِوار، وعلى تبادُل الرأي والنِّقاش، والنُّزول إلى الساحات العامة للقاء الناس، والاستماع إليهم، للزَّجِّ بهم في قضايا المجتمع، وفي السياسة، وفي اقتراح الأفكار، أي أنَّ العقل، بالنسبة للمدينة، هو عقل حَيٌّ، يَقِظٌ، ينزل إلى الشارع لِمُحاورة الشُّبَّان، ولتشويش يقينهم، وجعلِم يتساءلون، ويتشكَّكُون، وهذا ما لم يستوعبْه السياسيون والقُضاة، حين حاكموا سقراط، واتَّهَمُوه بالتَّشْكيك في الآلهة، وتحريض الشُّبان على الشَّك في المعتقدات، في الوقت الذي كان فيه سقراط، يُشَكِّك في اليقينيات التي تُعْطِبُ العَقْل، وتجرُّه إلى الاسترخاء والكسل، وإلى أن يصير عقل جواب واستعادة واجترار، يجترُّ القوانين والأعراف، ويُؤمن بأبديتها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، أي بتحويل الديمقراطية إلى دين.








