في أهمية التلاحم والتآخي في زمن فيروس كورونا
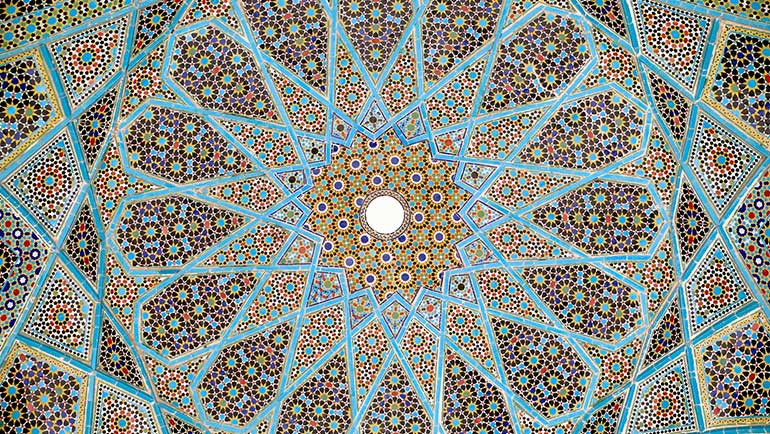
الدار/خاص
نشرت البوابة الالكترونية للرابطة المحمدية للعلماء مقالا للباحث بالمؤسسة، الدكتور عبد الهادي السلي، تطرق فيه لموضوع ” أهمية التلاحم والتآخي في زمن كورونا”.
الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على الشفيع المشفع صاحب الرسالة، وعلى آله وصحابته والتابعين، ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين
أما بعد، فإن الله سبحانه يبتلي عباده بالخير ليشكروا، كما يبتليهم بالشر ليصبروا، قال تعالى: ﴿ونبلوكم بالشر والخير فتنة﴾؛ تقريرا لسنة الابتلاء في الوجود، معطوفة على أصول النعم الست المقررة،([1]) و التي عليها مدار هذه الحياة، وبها كذلك حياة هذا الكويكب الذي نحيا به وفيه: فقد فتق السموات عن الأرض، وفي ذلك إشارة إلى نظرية السديم عند علماء الفلك الذين قرروا أن الشمس والكواكب والأرض كانت قطعة واحدة، كرة نارية، وفي سيرها الهائل السريع انفصلت عنها أرضنا، والكواكب السيارة من حولنا، ولو بقيت كتلة واحدة، لما كان ثمة مطر من سماء، ولا نبات من أرض، ولكنه فصل؛ ليجعل الماء أساس الحياة، والجبال رواسي للأرض؛ كي لا تميد بالناس في اضطراب، فلا يحصل لهم عليها قرار، ثم أسبغ على خلقه بنعم الطرق والمواصلات؛ إذ جعل بين الجبال مسالك واسعة نافذة؛ ليهتدي بها الناس إلى عموم المنافع، وخطير المصالح، ثم كانت السماء سقفا محفوظا كالقبة عليها، كما قال تعالى: ﴿ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه﴾ [الحج 22/ 65]، ولو وقع أدنى احتكاك أو اصطدام بالأجرام الفضائية ولو بالنيازك أو المذنبات الضخمة الدوارة في الفضاء لعم الدمار،([2]) ثم أسبل على الخلق بــ«الليل والنهار»؛ نعمة منه وفضلا؛ تحقيقا لهائل النفع بالظلام والسكون، والأنس والضياء، والتساوي أو التفاوت بينهما، و«الشمس والقمر»؛ إمدادا للأحياء بأشعتها، وإفادة للمزارع والثمار بضوئه.. وسواها من المنافع، ولكلٍ مدارٌ لا محيد عنه فيه يسبحون
فهذه أصول النعم الدنيوية ـ كما قال الفخر في المفاتيح ـ([3])، عطف عليها ـ سبحانه ـ ما يدل على توقيتها ونفي أزليتها؛ تبيانا لكونها من بابة الابتلاء؛ تماما كسائر ما يعتري الإنسان من الأحوال والأشياء؛ وهو عين ما قرره المفسرون في الآية، قال أبو القاسم بن جزي في تسهيله: « أي: نختبركم بالفقر والغنى، والصحة والمرض، والعز والذل، والشدة والرخاء، وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر، والشكر على الخير، أو خلاف ذلك»([4])
فالمآل المروم في قضيتي الشدة والرخاء واحد: عبادة الله صبرا وشكرا، وهو ما دل عليه حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر الله فله أجر، وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر، فكل قضاء الله للمسلم خير﴾ ([5])، وذاك من كمال الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره؛ ولذلك قيل: إن المسلم يتقلب في هذه الحياة بين عبادتي الصبر والشكر.
فبالأمس كنا في شهر الله الأبرك رمضان في صيام وقيام وابتهال؛ توثيقا لعرى العهد مع الله، وتجديدا للصلة به، وإن كان المؤمن دائب الوصلة مع خالقه؛ باقيا في كنفه وتحت مرضاته سبحانه؛ ثم مضى عيدنا في ظل هذه الظروف مفعما بالتضرع والدعاء أن يرفع الله هذا البلاء: وهكذا يجتمع للمؤمن في هذه الأيام: رمضان الأقدس، وعيد الفطر الأبرك، في سياق بلاء نزل بخلقه، تدل عديد المؤشرات على دفعه ورفعه؛ رحمةً من ربنا سبحانه وفضلا، ثم حزما من الجهات المختصة في ظل تظافر القوى، وتلاحف الجهود
وكل هذا يندب بعد الشكر والصبر إلى كثير من المعاني والقيم: كالوحدة والتآخي، والتضامن والتآزر بين المسلمين: غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، وما صدقة الفطر إلا نموذج للتضامن المنشود، والأخوة المرغوبة، أخوةٍ هي أعظم من أخوة النسب، ورابطةٍ هي أقوى من رابطة الدم.
أخوةٍ صانها ديننا الحنيف من جانب العدم فنهى عن كل ما يخل بها؛ لأن في اختلالها الشتات والوهن، ورعاها من جانب الوجود فرغب في كل ما يقويها، ويشد من عراها، ويشيع شأنها في الأمة والوطن، لأن بها التكاثف والتلاحم، والقوة والتفاهم، لاسيما في مثل هذه الظروف القاهرة؛ ولذا نجد كثيرا من الخلال والقيم يعززها ربنا سبحانه؛ ابتغاء فشوها في ربوع المجتمع، وذيوعها في أوساطه؛ ليتحلى بها الناس وحدانا وزرافات؛ حتى يصير الكل سليم الصدر، نقي الخلال، لا حقد فيه ولا حسد، لا غش فيه ولا بغضاء، قوي التآخي، متين الآصرة، لا ينظر إلى أخيه إلا على أساس من المحبة والتواد، يحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويكره له ما يكره لنفسه من الشر، يعينه إذا احتاج، ويؤازره إذا غُلب، يؤنس وحشته، ويزيل وحدته، يتضامن معه في الشدائد والكربات، ويصونه في عرضه ونفسه، يحفظ ماله إن كان له عاملا، ويصون كرامته وسمعته إن له كان أجيرا؛ لأن ذاك –عند المسلم- من تمام الإيمان، وكمال الإسلام، فالمسلم الحق ﴿من سلم المسلمون من لسانه ويده﴾ والمؤمن الحق ﴿ من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم﴾ قال ابن بطال رحمه الله: «والمراد بهذا الحديث الحض على ترك أذى المسلمين باللسان واليد والأذى كله؛ ولهذا قال الحسن البصرى: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر والنمل»([6])
وهكذا يمضي ديننا الحنيف في تثبيت دعائم الأخوة، ولحمة الوطن، حتى يجعل سلامة الصدر من الضغائن والأحقاد مفتاحا لأبواب الجنة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنا يوما جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة﴾، «فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه..» كان ذلك ثلاث مرار، ثم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فبات عنده ثلاث ليال؛ استكشافا لحاله وعمله، فلما ولت الثلاث قال ابن عمرو: «يا عبد الله.. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: ﴿يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة﴾. فطلعت أنت الثلاث المرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»؟ قال: «ما هو إلا ما رأيت». فلما وليت دعاني فقال: «ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه». قال عبد الله: «هذه التي بلغت بك، وهي التي لا تطاق» ([7])
إنما نال هذا الرجل ما نال، من أجل سلامة صدره، وطيب خاطره، لا يحمل إلا الود والاحترام، والتآلف والوئام، وهذا ما نرنو إليه، وما ينبغي أن نكون في مستواه؛ محاطا بالرعاية الكاملة، والاهتبال التام؛ لأنه سر وحدتنا، ومأرز قوتنا، وحافز نهضتنا، في الشدة والرخاء، في الصحة والوباء؛ إذ ديننا قد أحاطه لمثل ذلك بما مضى أو يزيد، وهذه مسائل ثلاث تبين ذلك وتجليه:
المسألة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى نهى عن التهاجر والتدابر بين المسلمين، فإن تخاصم المسلمان فلهما فسحة من الوقت، قدر ما يكفي لبرود نار الغضب، وزوال حمى الخلاف، وذلك ثلاثة أيام، ثم يحرم أن يتهاجرا فوق الثلاث؛ لما في ثقافة الهجر والتنازع من الخطر على التآخي والتلاحم، الخطر على جسم الأمة السليم، المتين بأخوته، القوي بوحدته، المتماسك بتراحمه وتعاضده؛ ولذلك كان جزاء المتهاجرين المتنازعين ألا يُغفرَ لهم، ولا تعرج أعمالهم إلى الله، فلا تُعرضَ أعمالُهم عليه سبحانه حتى يصطلحوا، قال صلى الله عليه وسلم: ﴿تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا ﴾([8]) ففي الحديث «أن المهاجرة والعداوة والشحناء والبغضاء من الذنوب العظام والسيئات الجسام، وإن لم تكن في الكبائر مذكورة، ألا ترى أنه استثنى في هذا الحديث غفرانها وخصها بذلك»، ويؤيد هذا أشد ما يكون التأييد ما صح من حديث أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه﴾.([9]) وسواها من الأحاديث التي قال عنها الحافظ في التمهيد بعد إيرادها: «وهذه الآثار كلها قد وردت في التحاب والمؤاخاة والتآلف، والعفو والتجاوز، وبهذا بعث صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله لما يحب ويرضى برحمته ولطف صنعه» ([10])
المسألة الثانية: أن الساعي في إصلاح ذات البين، الساعي في سحب أسباب التنازع والاختلاف، الساعي في التأليف بين أفراد الأمة والوطن، الساعي في تشييد الأمة المتآخية المتراحمة، أمة تتسع للجميع، وتقبل الكافة مهما تعددت الأفكار، وتنوعت الآراء، ينال الدرجة الرفيعة والرتبة المنيفة، بلا كد ولا نصب، قال صلى الله عليه وسلم: ﴿ ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، وإياكم والبغضة؛ فإنها الحالقة ﴾.([11]) قال في التمهيد: «وفيه.. أوضح حجة في تحريم العداوة وفضل المؤاخاة وسلامة الصدر من الغل»، وإنما غزرت المنح في شأنها، وعظمت الأجور في الحث عليها، والسعي في إشاعتها؛ لأن «صلاح ذات البين بها تقوم شعائر الإسلام من الصلاة والحج، وبها تحمى البيضة بالاجتهاد والنصرة، وبها تجمع حقوق الفقراء من أيدي الأغنياء».([12])
المسألة الثالثة: أن الله سبحانه حافظ على آصرة الأخوة، ولحمة التآخي حتى في أحلك المواقف، وأخطر الظروف، وأسوإ الأحوال، وأي ظرف أقسى من التناحر والاقتتال؟ ورغم ذلك فإن الأخوة ثابتة؛ لأهميتها، وباقية؛ لضرورتها، ولن ترفع أبدا؛ لخطورتها، قال تعالى:﴿وإن طائفتــن من المومنين اقتتلوا﴾ فسماهم مومنين، ثم أردف قائلا: ﴿إنما المومنون إخوة﴾؛ ولذلك قرر الفخر الرازي([13]) أن الآية جزيلة المبنى غزيرة المعنى في تقرير التآخي ونبذ التشرذم من جهات ست:
- أولاها: التعبير بـ«إن» إشارة إلى ندرة وقوع الاقتتال بين المؤمنين، ولو وقع وجب سريعا أن يرفع
- وثانيتها: التعبير بـ«الطائفة» دون «الفرقة»؛ إمعانا في تقليله، وحثا على الفرار منه واجتنابه.
- وثالثتها: التعبير بالظاهر (المؤمنين) مكان المضمر (منكم)؛ تنبيها على قبح ذلك، وتبعيدا لهم عنه.
- ورابعتها: تقديم ما حقه التأخير (طائفتان من المؤمنين)، وتأخير ما حقه التقديم (اقتتلوا)؛ ليكون الابتداء بما يمنع من الاقتتال، فيتأكد معنى النكرة المدلول عليها بكلمة «إن»؛ وذلك لأن كونهما طائفتين مؤمنين يقتضي أن لا يقع اقتتال منهما.
- وخامستها: التعبير بالماضي دون صيغة الاستقبال؛ إيماء إلى أنه نادر مؤقت دخيل، لا أنه كثير ثابت أصيل.
وأخيرا: التعبير بالجمع عند الوقوع (اقتتلوا)، والعدول عنه إلى التثنية عند رفعه بالصلح (فأصلحوا بينهما)؛ إشارة إلى أنه فتنة تكثر فيها الدخلاء، وتشيع فيها الأقاويل والآراء، وتتمزق فيها الجماعة شذر مذر، وأن الصلح درء للنزاع، وتقليل للخلاف، وجمع للكلمة، وتقوية للآصرة، وتمتين للحمة.
وبه ندرك موقنين أن الأخوة ينبغي أن تكون الرابطة المتينة التي لا يهدها شيء، ولا يقف في طريقها حدث، مهما كانت الأزمات، ومهما اختلفت المشارب، وتعددت الرؤى، وتنوعت المعارف، وتمايزت الأعراف والأعراق، وتضاربت المصالح؛ لأنها أكبر بكثير من كل هذا، وأوسع بكثير من كل هذا؛ إنها مظلة تظلنا، وساحة تسعنا فتجمعنا، وحصن حصين يحمينا، ولهذا المعنى قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ﴿لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا﴾، – ويشير إلى صدره ثلاث مرات -﴿بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه﴾([14])
هكذا يقر ديننا الحنيف أمر التآخي في مجتمعاتنا؛ لتصير تضامنا وتعاونا في أوقات الشدة كما في أوقات الرخاء، فــ﴿المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا﴾. قال القاضي رحمه الله: «فيه الحض على تعاون المسلمين وتناصرهم، وتآلفهم وتواددهم وتراحمهم. وتمثيله عليه الصلاة والسلام فى ذلك بالبنيان، وفى الحديث الآخر بــ﴿الجسد إذا شكا بعضه شكا سائره﴾ كله تمثيل صحيح، وتقريب للأفهام فى إظهار المعانى فى الصور المرتبة، فيجب على المسلمين امتثال ما حض عليه السلام عليه من ذلك والتخلق به»([15]) فالله نسأل أن يرفع هذا البلاء، ويفرج عنا هذه الكروب، ويديم علينا نعمة التلاحم والتآخي في صحة وعافية، وأمن وأمان، في بلدنا وسائر البلدان، آمين.
والحمد لله رب العالمين








