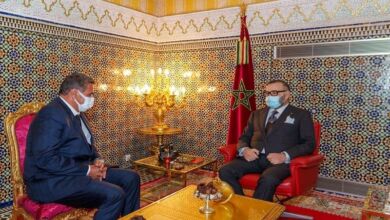الأمن الروحي الإسلامي في زمن الثقافة الرقمية (3/3)

بقلم: خالد حاجي*
هناك مؤشرات كثيرة تدل على انحسار واضح لصيغ الإجماع التقليدية في زمن الثقافة الرقمية؛ لقد صار من الصعب على السلطة السياسية في العالم الإسلامي اليوم أن تضيق على التوجهات العقدية أو الفكرية المختلفة بدعوى أنها تمثل تهديدا لأمن المجتمع الروحي؛ فقد أجبرت الفضاءات الرقمية والتدخلات الافتراضية كل السلط على تدبير الاختلاف والتعامل مع المخالفين في المعتقد والرأي تعاملا في فضاء مفتوح، يتوسل في الولوج إليه بوسائل افتراضية عابرة للحدود الرمزية والحسية.
تماما مثلما ألغى السلاح الافتراضي المسافة بين المجال العسكري والمجال المدني، حيث أصبح بمقدور الفرد الواحد أن يحدث من الخسائر ما لا تحدثه الجيوش المنظمة، كذلك ألغت الوسائل الرقمية الحدود بين مؤسسة العلماء بوصفها سلطة منظمة متجانسة تسهر على الإجماع، وبين أفراد يبشرون بتصورات ومفاهيم وآراء لا تنضبط بضوابط هذه السلطة. لم يعد القول الفصل بين السلطتين، سلطة الفرد وسلطة الجماعة العالمة، يعتمد على الحجة العلمية وقوة الاستدلال ووفرة الإحالات على المذهب والاحتماء بإطاره المرجعي، بل صار يعتمد على ما يمكن أن يحدثه من « طنين » ( Buzz ). لم تعد الحقيقة الدينية منوطة برجاحة الرأي المستساغ في سياق مجتمعي بعينه، بل صارت منوطة بقدرة الجهة التي تصوغها على توصيلها إلى أكبر عدد من المتلقين.
من آثار الثقافة الرقمية أنها ربطت الخطاب الديني العلمي بفنون التواصل، ولما أصبح الأمر كذلك انهارت كل السلط الدينية التقليدية التي كانت تستمد شرعيتها من الانتساب إلى منظومة تراثية أصولية وأصيلة، وجعل يحل محلها سلط جديدة قادرة على توصيل المعلومة الدينية في فضاء رقمي متحرر من سطوة المكان. وقد نتج عن هذا الاقتران بين الحقيقة العلمية والقدرة على التواصل والتوصيل أن برزت إلى السطح « شعبوية علمية » تقوض كل الأسس التي كانت تقوم عليها المعرفة الدينية، وبالتالي أصبح من العسير الظفر بإجماع يقوم عليه أمن المجتمع الروحي. فلم يحصل وأن تباعدت الشقة بين المؤسسة العلمية المتحيزة في المكان وبين المتلقين للخطاب الديني مثلما تتباعد اليوم.
وعليه فقد أصبحت الحاجة إلى إعادة صياغة مفهوم الإجماع حاجة ماسة، تقف في وجه بلوغها عقبات كثيرة، أولها أن نتائج هذا الإجماع وطرق الوصول إليه أصبحت شأنا عاما لا يخص المسلمين لوحدهم، بل العالمين كلهم. فقد انهارت الحدود بين الداخل والخارج، وبين الذات والغير، وهو ما تمخض عنه نزوع قوي نحو « الحس المشترك ». فلم يأخذ المسلمون مسافة نقدية من خطابهم الديني التقليدي مثلما يأخذونها اليوم، وما ذلك إلا لشعورهم بأن المعتقد الديني لم يعد شأنا خاصا لا يعلمه الآخرون، بل صار أمرا يعرض على أنظار الآخرين، يقلبونه على وجوهه كيفما يشاؤون. وصارت تأثيرات المعتقد تعرض في سوق القيم الكونية، فتعلو قيمته أو تنخفض.
يمكن أن نقول باختصار أن الآليات التي كانت تعتمد لتسييج الأمن الروحي للبلاد الإسلامية، والتي ذكرنا من بينها آلية الإجماع على سبيل المثال، لا الحصر، لم تعد قادرة على إنتاج المعنى المناسب لطبيعة السياق الثقافي العالمي المفتوح، ولروح العصر والبيئة التشريعية الحديثة والذوق العام. لقد صار إنتاج المعنى الضروري لمسايرة العصر ولضمان تماسك المجتمع في زمن الثقافة الرقمية يقتضي التمكن من الأسلحة والأدوات الافتراضية الضرورية.
فهذا النموذج من التحديات التي تواجه اليوم « الأمن الروحي » للمجتمعات الإسلامية في زمن الثقافة الرقمية يؤشر على وجود منعطف خطير في إدارة الحروب وفنونها. فبعد أن كان المتحاربون يتوسلون بالأسلحة التقليدية الثقيلة لإخضاع الأبدان وهزم الأجسام، أصبحوا اليوم يتوسلون بالأسلحة الافتراضية اللطيفة للاستحواذ على النفوس والهيمنة على الأرواح، كما أسلفنا الذكر عند وقوفنا مع حالة القوة الناعمة.
أثبتت الأحداث المتتالية نجاعة الأسلحة الرقمية اللطيفة، وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، في تفكيك جميع السلط داخل المجتمعات العربية الإسلامية، بما فيها السلطة الدينية، آخر قلعة من قلاع الدفاع عن أمن المجتمع الروحي وخصوصيته. كان المنطلق من تعميم المعلومة الدينية تعميما تغيّر معه الوعظ الديني، حيث أصبح بمقدور كل فرد، مهما كانت معرفته الدينية متواضعة وضئيلة، أن يمارس الوعظ الرقمي، متحللا من كل شروط الوعظ، سياقا وزمنا ومكانا. يكفي أن يتوفر المرء على هاتف نقال وأن يستطيع الدخول إلى أحد محركات البحث كي يتحول إلى واعظ رقمي، ينتقي من أحاديث غيره من المشايخ والفقهاء والعلماء والوعاظ مادة يعيد ترتيبها بحسب ميوله العقدي وهواه الإديولوجي، فيحذف ما يشاء ويضيف ما يشاء، قبل أن يدبجها بعنوان من عنده، يحدد به سياق تأثيرها الجديد، كأن ينتقي خطبة تتحدث عن العدل مثلا، فيضع لها عنوانا يحيل على أحداث اجتماعية أو تجاذبات سياسية أو غير ذلك.
إذا كان من المفروض أن يكون للوعظ الديني زمن ومكان متعارف عليهما بين الواعظ والموعوظ، فليس الأمر كذلك بالنسبة للوعظ الرقمي، حيث يختار الواعظ الرقمي متى يبث رسالته، ومن هم المستهدفون من هذه الرسالة، فتجده يبعث بها عبر وسيلة من وسائل التواصل مثل « الواتس آب » في الصباح الباكر أو وسط النهار أو في جوف الليل، دون مراعاة لحالة الموعوظ الشعورية ومدى استعداده لتلقي الخطاب الوعظي أو التفاعل معه. وهكذا أصبح الفضاء الرقمي يعج بمواعظ وأحاديث وخطب لا يتوقف صبيبها، مما أدى إلى فك الارتباط بين الخطاب الديني وفضائه وأزمنته المقدسة، وهو ما سهل ابتذاله، وتجريده من القدرة على النفاذ إلى الأرواح. فقد لا يلبث المرء أن يتفاعل مع موعظة دينية وصلته، حتى يفتح الرسالة التالية فتنقله إلى عالم الرياضة أو السياسة أو الهزل مثلا.
لقد كان لوسائط التواصل الاجتماعي الجديدة أثر بالغ في تغيير أنماط الاستهلاك للخطاب الديني؛ فبعد أن كان هذا الخطاب يتداول في إطار طقوس مقررة تهيأ المتلقي التهييء الروحي اللازم لاستقباله، أصبح اليوم يقتحم على هذا المتلقي فضاءه الرقمي، يصله وسط صبيب من المعلومات لا ينقطع. لم يعد تلقي الخطاب الديني والموعظة الدينية جزء من تجربة روحية يطلب صاحبها التعمق في البحث عن الحقيقة الدينية المتعالية، بل أصبح مادة فرجة تعرض في إطار ثقافة التسلية. لا عجب أن يفرغ هذا الخطاب من محتوياته الدينية ويعجز عن ملامسة الروح والارتقاء بالتجربة الروحية. كيف لمن يُقذَف بعشرات المواعظ يوميا أن يميز بين الخبيث منها والطيب، بين الصالح والطالح! إن وفرة العرض للمعلومة الدينية أفقدت المتلقي القدرة على التمييز، وأدخلت المجتمع في فوضى عارمة تعبد الطريق للعزوف عن الدين والنفور من السلطات الناطقة باسمه.
وقد زاد من تعقيد الوضع بروز أئمة ودعاة جدد، هم أقرب إلى طلاب النجومية منهم إلى الإمام أو الداعية التقليدي. ذلك أن الثقافة الرقمية تتيح لهذه الفئة الجديدة اصطناع رعايا روحيين بعيدا عن سلطة المؤسسات الدينية الرسمية المرتبطة بجغرافيا « المجتمع الإسلامي أو الدولة الإسلامية » كما صيغت من داخل هذه المؤسسات. فقد يكون لهذا التحرر أوجه يحمد بها، كأن يوسع آفاق النظر في أمور الدين وعلاقته بواقع الناس المعيش، ويذكر بأبعاد روحية لا تستوعبها المؤسسة الدينية كيفما كان نوعها ومهما كانت شرعيتها؛ وذلك لو لا وجود مخاطر جمة تحدق بهذا التحرر، يأتي على رأسها خطر انفراط عقد المجتمع القائم على الإجماع الديني، والزج به في مستنقع « التدين الطهراني »، الذي من خصائصه القفز على السياق، سواء أكان هذا السياق تاريخيا أو مجتمعيا، بغية الوصول إلى الحقيقة الدينية الخالصة الطاهرة.
لقد دخل العالم زمنا افتراضيا انتعشت فيه كل أنواع الفكر الطهراني؛ فجعل أصحاب هذا الفكر يتربصون خارج حدود الأغلبية، ينتظرون وقت الانقضاض على الأسس التي يقوم عليها المجتمع. لم يعد بالإمكان تحديد هوية المذهب العقدي لمجتمع إسلامي ما خارج دوائر السلطة السياسية المتحكمة. فأنت لو استفتيت المجتمع الإسلامي اليوم، لوجدته منقسما على ذاته، تتوزعه أقليات كثيرة تكاد لا تجتمع على عقيدة أو مذهب؛ وما ذلك إلا لأن الديناميات التي أطلقتها وسائل التواصل الاجتماعي هي ديناميات « طاردة »، غير « جابذة »، تسعف في التفكيك أكثر مما تسعف في التجميع. حين تضع التوابث والمشترك محط نقاش مفتوح داخل الفضاء الافتراضي، فعندها لا تأمن أن يضيع الإجماع.
أمام هذه التحديات الجديدة نتساءل: ما العمل؟ إذا انهارت الأغلبية كمكون أساس يقوم عليه أمن المجتمع الروحي، فعلى أي أساس آخر يقوم هذا الأمن؟ وكيف السبيل إلى تحقيق هذا الأمن إذا ما تم فك الارتباط بين التسييج العقدي والتسيج الجغرافي لهوية المجتمع؟ هل يكفي أن ننتج كتيبات ودفاتر حول مذهب البلد الإسلامي كي نجنب أهله الوقوع في أحضان المذاهب الأخرى التي قد تكون مصدر إزعاج أو تهديد لأمن هذا البلد الروحي؟
نبدأ بالسؤال الأخير المتعلق بإمكانية إنتاج مادة علمية تساهم في تأطير المجتمع دينيا بغية الحفاظ على استقراره الروحي وأمنه. وظننا أن هذا التوجه، على أهميته، قد يسقط أصحابه في حكم من يخادع نفسه وهو لا يشعر، وذلك متى فاتهم التنبه إلى أننا في ثقافة رقمية تحول معها الإنسان إلى منتج-مستهلك، كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك. لم يعد المقبل على المواقع الاجتماعية مجرد متلق خامل ينتظر من يجود عليه بمعلومة دينية أو غيرها، بل صار يحدد مجالات اهتمامه بمجرد انخراطه في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وتحديده لأصدقائه ودائرة معارفه. يكفي أن يفصح عن ميوله العاطفي واهتمامه الفكري لتتولى القوة الناعمة القابعة وراء الذكاء الاصطناعي مهمة ربطه بما يميل إليه. فلعله من الوهم التمادي في الاعتقاد بأن أنماط التواصل التقليدية لم تزل قائمة وأنه بمقدور الملقي للخطاب الديني الرسمي أن يخاطب الناس كما كان يخاطبهم قبل الفضاء الافتراضي، أي أن يُحدِّث وهم يسمعون.
إن مثل المرجعية الدينية في علاقتها مع المقبلين على الخطاب الديني هو نفسه مثل الأحزاب السياسية مع الجماهير. قديما كان بمقدور الحزب السياسي أن يخاطب فئة عريضة من الجمهور في ساحة عمومية بغرض تبليغ رسالته الإيديولوجية وبرنامجه السياسي؛ أما اليوم فقد صار لزاما على كل حزب أن يخاطب الأفراد، كل في موقعه، بحسب ميولاته، وهو الأمر الذي أصبح يقتضي التوفر على بحر من المعلومات؛ لقد صارت قوة الأحزاب السياسية وضعفها رهينين بمدى توفرها على هذه المعلومات وبمدى قدرتها على معالجتها بذكاء اصطناعي رقمي خارق. نستنتج من هذا أن رسائل الحزب السياسي الإيديولوجية وبرامجه السياسية أصبحت لا تساوي شيئا في مقابل قدرتها على جمع المعلومة ومعالجتها المعالجة الفعالة. ينبئ هذا التحول بتراجع قوة الأحزاب السياسية أمام القوة المالكة للمعلومة القادرة على توظيفها. وإذا لم تسلم كبريات الأحزاب السياسية في أوروبا من الوقوع في أسر هذه القوة، فهل بإمكان السلطة الدينية في العالم الإسلامي أن تفلت من هذا الأسر؟ أقل ما يمكن قوله ردا على هذا السؤال هو أن القوى المتحكمة في العالم الافتراضي أصبحت تزاحم السلطة الدينية في تأطير الإنسان المسلم والتأثير عليه.
ما العمل إذن؟ يجد العالم الإسلامي نفسه اليوم أمام خيارين اثنين؛ إما خيار فك الارتباط بالعالم الجديد، العالم الافتراضي والثقافة الرقمية، ثم العودة إلى العالم القديم، بموازين قواه المألوفة، وبحسه الجغرافي المكين، وبأغلبيته الواضحة؛ وهذا الخيار غير واقعي بالنظر لمستوى تشابك المصالح بين المجتمعات وتوقف قضاء هذه المصالح على التداخل بين العالمين، العالم الحقيقي والعالم الافتراضي الرقمي. وإما خيار التوسل بأحدث الوسائل الافتراضية لبلوغ أنبل الغايات الأخلاقية والروحية؛ مع ما يرافق هذا الخيار من مخاطر وما يحيط به من منزلقات؛ حيث لا شيء يضمن ألا تنطلي هذه الغايات النبيلة بطلاء الوسائل الممتطاة لبلوغها.
ولعل جزءا من الحل هو الوعي بوجود عالم جديد يحيط بنا، وبتحول مركز القوة في هذا العالم من القوة التقليدية إلى قوة افتراضية غلبت الذكاء الاصطناعي على الذكاء الطبيعي، ومكنت للأقلية على حساب الأغلبية، وجردت الإنسان من حس الانتساب إلى جغرافيته وزجت به في عوالم افتراضية. ويستتبع الوعي بهذا العالم الجديد بالضرورة وعيا نقديا وحسا استشرافيا يمكنان من فتح أفق جديد للتأمل في مستقبل الأمن الروحي للمسلمين.
هل يستسيغ المسلم اليوم إخراج المخالف له في الاعتقاد من جغرافية الإسلام، إلا إذا كان داعشيا، محسوبا على الغلاة في الدين؟ وبالمقابل، ألا يعني قبوله بنموذج مجتمعي لا ينبني على الأغلبية بالدخول في عصر « اللا-مجتمع » الذي بشرت به رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر سنة ١٩٨٧ ( There is no society )؟ هل تحتاج المجتمعات الإسلامية إلى روح جديدة — على غرار ما قاله جاك دولور بالنسبة لأوروبا ( Il faut donner une âme à l’Europe ) — روح تسمو على روح الأغلبية والأقلية على السواء؟ قد تبدو هذه الأسئلة غير ذات راهنية، لكن الجواب عنها هو الذي سيحدد مستقبل الأمن الروحي للمجتمعات الإسلامية، في عالم أصبح ينعت بـ « عالم ما بعد-الحقيقة »، عالم أصبح في أمس حاجة لروح.
باحث وكاتب *